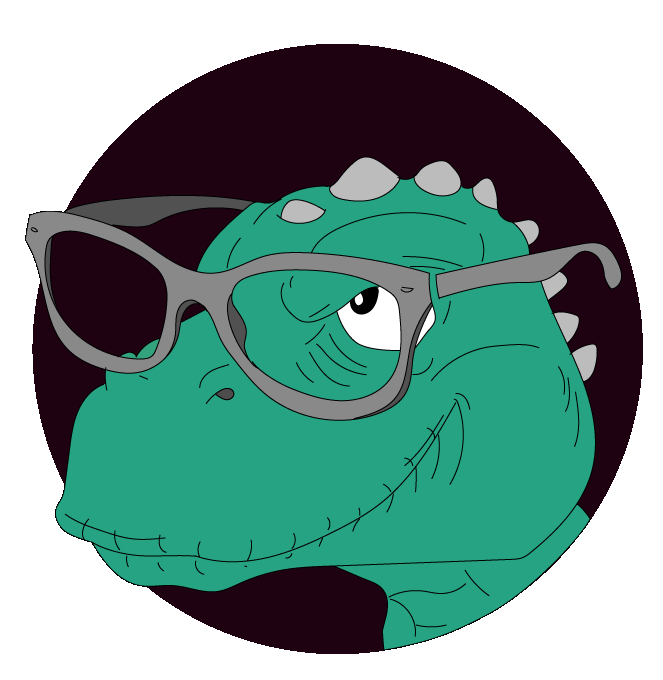في زمننا الحالي، صار التخصص غالبًا على الثقافة، وصار ينظر لهما كضدين لا يجتمعين. فصار البعض ينظر للثقافة كشيء أقل أهمية من التخصص وفائض عن اللزوم، بل يرى البعض أن الثقافة قد تودي بالمرء إلى الجهل المركب، بخلقها وهم المعرفة. وفي العقود الأخيرة، أصبحت الثقافة مرادفٍ للأمركة. إذ اختزل البعض الثقافة في عدد الأفلام الهوليوودية المشاهدة وعدد أسماء الممثلين الأجانب المحفوظة ظهرًا عن قلب وإلخ، كما اُختزل تعلم اللغات في لغة واحدة، وهي اللغة الإنجليزية؛ فصارت كل هذا مقياسًا جديدًا للثقافة.
أما إذا كنت تعرف عن أفكار كارل ماركس، وهيجل، وباكونين، وجون لوك، وروسو، وهوبز، وطه حسين، وسلامة موسى، ومحمد عابد الجابري، وجورج طرابيشي، وسلامة كيلة وغيرهم، فذلك يُعد خروجاً عن تخصصك إذا كان مجال تخصصك مختلفاً، كأن يكون الطب مثلاً. وإذا لم يكن لديك تخصص معين، فإنك تُعتبر مصاباً بالجهل المركب. ورغم أن سلامة موسى قد سبق وطرح سؤالاً مماثلاً، إلا أن لكل عصر متغيراته، ولهذا السبب ينبغي أن نطرح السؤال مجدداً: لماذا نثقف أنفسنا؟
يقول سلامة موسى في كتابه «كيف نربي أنفسنا»: إنّ «إحدى غايات الثقافة هي أن نُكسب الحياة دلالة ومغزى؛ أي إننا نحس أننا لا نحيا الحياة البيولوجية التي لا تختلف عن حياة الحيوان». يُحاجّ موسى هنا بأن الحياة بلا ثقافة هي حياة بلا معنى، أقرب إلى الحياة البهيمية الفارغة. إذن، يضع الثقافة كممايزٍ للإنسان عن الحيوان. كما ميّز أرسطو سابقًا بين الإنسان والحيوان بالعقل أو الخطاب (λόγος)، وبالقدرة على التمييز بين العدل والظلم. غير أن أرسطو كان على خطأ (وهو أمر طبيعي نظرًا لمحدوديات عصره) بشأن تمايزنا عن الحيوانات من ناحية القدرة على تمييز الظلم من العدل، فقد أثبتت التجارب الحديثة أن بعض الحيوانات الأخرى، مثل قرود الرسوس، قادرة على ذلك أيضًا. ومع ذلك، فإن معيار التمايز الذي وضعه سلامة موسى هنا (الثقافة) هو أكثر دقة.
أما نيتشه، فيقول في كتابه «شوبنهاور مربيًا» أن البهائم «لا تمتلك القدرة على توجيه شوكة المعاناة نحو نفسها وتفهم وجودها ميتافيزيقيًا»، مما يعني أن ما يميزنا عن الحيوانات الأخرى هو القدرة على تقديم مغزى للمعاناة في الحياة، وقدرتنا على فهم معاناتنا، حتى لو لم يكن لها معنى موضوعي بالضرورة. الثقافة إذًا تعطي معنى للحياة، ولا تكون ممكنة إلا لذوي العقل الأكثر تطورًا، مثل الإنسان. وبما أن المعاناة جزء أصيل من الحياة، فإن الثقافة تسهم في فهم هذه المعاناة.
من ناحية أخرى، يؤكد سلامة موسى أن التخصص بدون ثقافة يخلق إنسانًا محدود الأفق، والإنسان محدود الأفق سيكون أقل تسامحًا وأكثر عرضة للانقياد وراء نزعات متطرفة ومتعصبة. ولنأخذ على سبيل المثال شخصًا متخصصًا في اللغة العربية فقط، وهو أستاذ جامعي، بيد أنّ تخصصه لا يمنعه بالضرورة من أن يكون ضحية لأفكار عنصرية. وهذا ما نراه في الواقع؛ نجد أشخاصًا، مثل الأطباء والمهندسين والمحامين، قد يقعون فريسة سهلة للأفكار غير التسامحية والعنصرية. ولا يعني هذا أن التخصص سيئ، لكن التوقف عنده هو الخطأ. ففي هذا الشأن، يؤكد سلامة موسى بقوله: «ليس هناك شك في ضرورة التخصص، ولكن الرجل المثقف يرفض الحدود والسدود، ويستبيح لنفسه جميع المعارف؛ لأنه يحس أنه محتاج إليها وأنه ينمو بالاغتذاء بها، بل هو يتطور بها، والتطور حق بل واجب على كل إنسان».
لذا دعونا نتعمق أكثر في مخاطر انعدام الثقافة بين الشباب، ولنأخذ مثالًا من حياتنا المعاصرة، بعيدًا عن العالم العربي، غير أنه ينطبق علينا أيضًا. ولننظر إلى الولايات المتحدة كمثال. إذ كان صعود ترامب دليلًا هامًا على ما يمكن أن يشكله انعدام الثقافة والوعي في المجتمع الأمريكي. فقد لاقى شعار «لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا» إعجابًا كبيرًا من شريحة واسعة من الشعب، ولا يزال صداه يتردد حتى الآن، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2024.
وبسبب غياب الثقافة والوعي، وخصوصًا التفكير الناقد الذي اعتبره جزءًا من الثقافة العامة، لم يسأل الأمريكيون أنفسهم الأسئلة الناقدة الضرورية: ما الذي يقصده ترامب بـ«عظيمة مجددًا»؟ ومتى كانت أمريكا عظيمة حقًا؟ إنّ طرح هذه الأسئلة يتطلب مهارة التفكير الناقد، ولكن الإجابة عليها تتطلب أيضًا ثقافة واسعة. ويمكن أن يقودنا السؤال الأول إلى احتمالين: الأول هو أن القصد عظمة الهيمنة على العالم وهيبة الولايات المتحدة، والثاني هو حالة اقتصادية سابقة كانت فيها البلاد مزدهرة. فإذا كان المقصود هو العظمة الأولى، فينبغي أن يسأل المواطن الأمريكي نفسه: ما شأني كمواطن أمريكي في هذا كله؟ وإذا كان المقصود هو الازدهار الاقتصادي، فيجب أن يسأل: متى كانت أمريكا في عز ازدهارها الاقتصادي؟ وما هي انعكاساته على المواطنين؟ هل وفرت تعليمًا مجانيًا، أو صحة مجانية، أو خدمات مجانية؟! وهل خلقت نوعًا من العدالة الاجتماعية والاقتصادية، فمنعت الغني من استغلال الفقير؟! أما إذا كان يقصد الحالتين معًا، وهو المرجح، فينبغي أن يوجه لنفسه كل تلك الأسئلة ضربة واحدة. سنجد أنه من خلال محاولة الإجابة على هذه الأسئلة، يتبين أن مفهوم العظمة عند ترامب لم يخدم بشكل رئيس 99% من الشعب. ولهذا السبب، لا يكون للمواطن البسيط أي سبب عقلاني للتصويت لترامب. فيصبح شعار ترامب مجرد شعار شعبويّ (ميّز عن شعبيّ)، لا هدف له سوى استمالة عاطفة الشعب القابع في الجهل نتيجة لسياسات التجهيل التي لم تنحصر على الثقافة العامة لكن أيضًا على التعليم المتخصص الذي حرم منه الكثيرون نتيجة لتحول التعليم التخصصي إلى سلعة تجارية.
إن الثقافة، باعتبارها مولدًا للوعي، هي أداة توجه المواطنين نحو الاهتمام بأولويات حياتهم الواقعية، وتحميهم من أن يقعوا ضحايا للشعارات الدينية والشعبوية التي لا تعمل إلا كواجهة لمصالح نخبة ضيقة. ويجدر التنبيه، بأننا لا نقول بضرورة الثقافة على نطاق الشعب بأكمله، ولكن على الأقل شريحة كبيرة منه يجب أن تكون كذلك.
غير أنه لا ينبغي أن نتوقع من الحكومات أن تبادر بتشجيع الثقافة، لأن ذلك غالبًا لن يخدم مصالحها. فالحكومات هي نتاج للبنية التحتية الاقتصادية، وهدفها الرئيس سيكون دومًا الترويج لأيديولوجية الطبقة المسيطرة1 . كما أنه ليس من مصلحة أي نظام طبقي أن يخلق شريحة مثقفة بشكل واسع، لأن ذلك يعزز وعي الفرد ليس فقط بمصلحته كمواطن، بل أيضًا بوعيه بالطبقية والتراتبية وعبوديته. فالشخص غير الواعي يبقى عبدًا مستغلًا دون أن يدرك ذلك. إذًا، فإن الدعوة للثقافة هي في جوهرها دعوة للوعي، وبالتالي دعوة ثورية. إذ تصبح الثقافة هنا ليست فقط أداة فردية للاستبطان2، بل أيضاً أداة ثورية مهمة إذا استُخدمت بشكل صحيح.
وقد أشرنا في مقدمة هذا المقال إلى كيف تم اختزال الثقافة في الأمركة، ليس فقط في مجال الأفلام والأغاني وإلخ، بل أيضًا على مستوى الكتب، حيث تُصدر لنا كتب أمريكية تجارية خالية من أي معرفة حقيقية، فتخلق وهمًا بالثقافة ووعيًا مزيفًا. فليس كل كتاب يقود إلى الثقافة، وليس كل قارئ مثقفًا، إذ يعتمد هذا بشكل كبير على نوعية الكتب. ولكن بما أن البنية التحتية (الاقتصادي) تحدد البنية الفوقية (السياسي والأيديولوجي والثقافي)، فلا عجب أن تُترجم هذه الكتب التجارية الأمريكية للعربية. فالبنية التحتية إذًا تحدد الأفكار السائدة والكتب، بل وتُعرّف الثقافة والمثقف بما يتماشى معها ومع مصالح الطبقة المسيطرة.
وفي ضوء ما تقدم، يتضح أولًا أن الأمركة لا تعدو كونها مجرد تأثر ثقافي، بل أداة تغييب مناهضة للثقافة الحقيقية، كنتيجة حتمية مادية للبنية التحتية للنظام الرأسمالي، وبذلك فهي ليست حصرًا على العرب، بل ظاهرة عالمية. وثانيًا تتضح أهمية الثقافة كضرورة لا غنى عنها لتكوين هوية الإنسان وتطوير تفكيره الناقد. وليست الثقافة مجرد ترف فكري زائد عن الحاجة، بل هي ركيزة أساسية تميز الإنسان عن الكائنات الأخرى، وتمنحه القدرة على فهم معاناته وإيجاد معنى لحياته. دون التثقف، يبقى الإنسان محدود الأفق، عرضة للتطرف والجهل، غير قادر على مقاومة الشعارات الشعبوية والتلاعب الأيديولوجي.
إن الثقافة هي السبيل لتحقيق وعي أعمق بالذات والمجتمع، والوسيلة لمواجهة الهيمنة الثقافية والتبعية الفكرية التي تروجها الطبقات المسيطرة. الثقافة تُعتبر دعوة ثورية، تعمل كأداة لتحرير الفرد من قيود الجهل والتبعية. وإن السعي نحو الثقافة ليس ترفًا، بل واجبًا حتميًا لكل إنسان يسعى لتجاوز حدود تخصصه الضيقة، ليصبح إنسانًا واعيًا قادرًا على الإسهام بفعالية في بناء مجتمع أكثر عدلًا وتسامحًا ووعيًا. لذا، ينبغي العمل على تعزيز الثقافة في مجتمعنا العربي كأداة للتحرر والتقدم.
الهامش
تنويه: هذا المقال لا يمثل بالضرورة رأي أو اتجاه سياسور
احرص على أن يصلك كل جديد عن طريق الاشتراك في النشرة البريدية