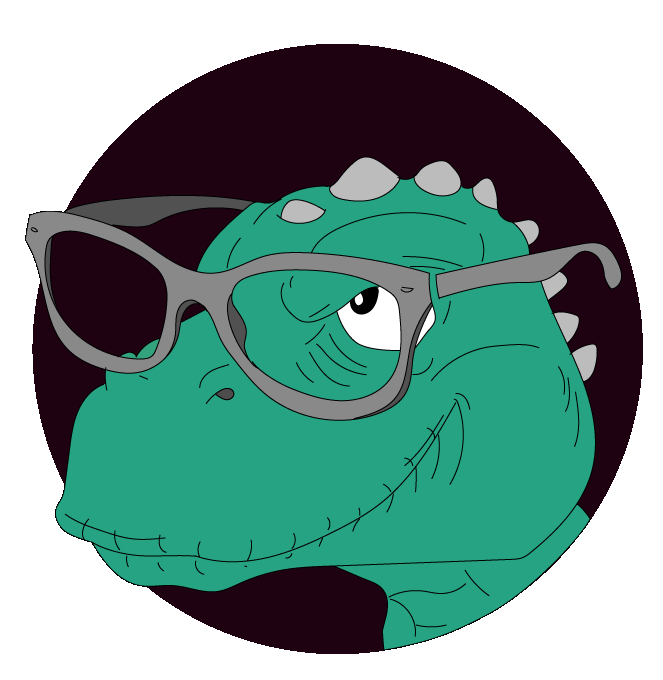ثنائية الخوف والغضب
«أنتم متطرفون يا عيالي»، هكذا كانت والدتي تبدأ توبيخها لأبنائها -وأنا منهم- حين كنا نقبع أمام التلفاز أو نتصفح الإنترنت لساعات طويلة، أو عند البقاء طويلًا مع ألعاب الفيديو، وربما أيضًا التسكع مع الأصدقاء لوقت متأخر، مهملين أشياء أخرى كان يجب -كما ترى- أن نقوم بها. ومحددة بذلك أن التطرف هو عدم الاتزان في أداء الواجبات وممارسة النشاطات. فما التطرف حقًّا؟
الشخص القابع في منطقة الوسط هو شخص ميت لا يوجد في عالم الأحياء.
التطرف يمكن تصويره في حركة البندول من طرف إلى طرف آخر مرورًا بالوسط. وحياتنا تشبه ذلك البندول، فعلى الرغم من أننا قد نكون في الوسط أحيانًا، إلا أننا نتأرجح في حياتنا من طرف اليمين إلى طرف اليسار، إن الشخص القابع في منطقة الوسط هو شخص ميت لا يوجد في عالم الأحياء. وربما مهاجمة التطرف عمومًا لا تبدو في نظري منطقية أو ممكنة، إذًا يرتبط التطرف أحيانًا بشغف شخصي وغريزة إنسانية تتعلق بإثبات الذات. كما لا أعتقد أن حياة بلا تطرف – بإطلاق اللفظ – يمكن أن توجد، فلولا تطرف بعض العلماء في معاملهم رغبة في الوصول إلى نتائج معينة لما حصدنا ما حصدناه من فوائد علمية، ولولا تطرف الموسيقيين لما رأينا الموسيقى الخالدة والإبداعية. ففي الكثير من الأحيان يرتبط الإبداع بنوع من التطرف.

لكن لمزيد من التبسيط في فهم التطرف يمكن أن نحيله إلى نوعين: تطرف تجاه الذات، يمارسه الشخص تجاه ذاته ولا يتوجه به إلى المجتمع بشكل مباشر، وإن وجد تأثير غير مباشر مثل الإخلال ببعض أدواره المجتمعية بالإضافة إلى أن مبرراته يمكن أن تكون مرتبطة بالمجتمع كمحاولة إثبات الذات في المجتمع وتحقيق التمايز والفردية، كما لا يقتضي بالضرورة أن يكون إيجابيًا أو سلبيًا (كالأمثلة السابقة الذكر). وهناك تطرف تجاه الآخر، وأقصد به تطرفًا يتولد لدى الفرد تجاه فرد آخر أو مجموعة أو المجتمع ككل، وهو ما يهمنا هنا.
التطرف يظل محصورًا في حق التعبير عن الرأي.
التطرف والوسطية هما مصطلحان يقاسان مجتمعيًا، أي وفق مفاهيم المجتمع لما هو مقبول وغير مقبول. ويمكننا القول أيضًا إنهما يقاسا مكانيًا وزمانيًا، فما ينظر إليه في زمن ما باعتباره تطرفًا ربما كان غير ذلك في وقت سابق. وقبل الشروع في توصيف التطرف يجب أن نوضح أنه كثيرًا ما يتم الخلط بين مفهومين هما: التطرف والإرهاب. وفي حقيقة الأمر يوجد اختلاف واضح ومهم بينهما.
فالتطرف هو توصيف المجتمع لسلوك أو رأي أو اتجاه فكري بكونه غير مبرر وغير مقبول ويحرض ضد قيم المجتمع وأسسه وربما يؤسس للعنف (ويظل في رأيي محصورًا في حق التعبير عن الرأي والذي يجابه بالرأي المضاد، مالم يتحول إلى عمل «إرهابي» أو تحريض مباشر تترتب عليه أعمال عنف). فيما يشكل الإرهاب مرحلة لاحقة تقتضي ممارسة الترهيب والعنف الذي يهدف إلى التأثير على السلطة الحاكمة أو المجتمع بغرض النهوض بقضية سياسية أو أيديولوجية أو دينية.
كما يبدو واضحًا بأن قضية التطرف لها أبعاد وأسس متنوعة ومتعددة ويصعب بحال من الأحوال الإلمام بها من زاوية واحدة. ولكون هذه الأسطر لا تزيد على كونها مقالًا سنمارس من خلاله نوعًا من التفكيك الذي يهدف إلى الحديث بشكل مبسط عن هذه الظاهرة من إحدى زوايا فكرة التطرف بمعناه القابل للتحول باتجاه المجتمع (التطرف تجاه الآخر).
القطة التي تحُشر في الزاوية تهاجم بشكل غير مدروس (انتحاري).
وعلى الرغم من أن التطرف تجاه المجتمع ينتج لأسباب ومبررات مختلفة تتصل بتحليلات نفسية متعددة وظروف اجتماعية محددة، إلا أننا سوف نحصر المقال -لغرض التبسيط والتركيز- على ثنائية الخوف والغضب، ودورهما في خلق التطرف باعتبارهما من العوامل سهلة التحول في العادة من سلوكٍ فردي إلى سلوكٍ جمعي.
فالخوف ينشأ من وجود تهديد أو خطر ما، أو من الإحساس بمستقبل مجهول وغامض. ومن الخطر على المجتمع أن تصاب مجموعة ما بشعور الخوف من الجماعات الأخرى، فهو إحساس شبيه بتلك القطة التي تحُشر في الزاوية فلا تجد بدًا من التطرف المرتبط بالهجوم غير المدروس (انتحاري) نحو الخصم فتقاتل بكل ما لديها من قوة.
ومن أمثلة الخوف الذي يدفع نحو التطرف هو الخوف الناتج عن تهديدات الهوية، سواء القومية أو الوطنية أو الدينية، وهي مسألة ناقشها الكثير من المفكرين والفلاسفة وكثيرًا ما نُظر إليها باعتبارها إشكالية في فهم الهوية وتراتبيتها في سلم أولويات الانتماء.
الجماعات التي تعاني من القمع إما أن تكون جماعات منزوية أو ناقمة غاضبة.
وعلى المستوى الفردي، فالخوف لدى الفرد نتيجة لدور القمع الذي يمارسه المجتمع تجاهه وتجاه اختياراته وتقييد هويته الفردية وتدفعه -باعتباره الحلقة الأضعف وفي نوع من التكيف- إلى الخنوع والخضوع الناتج عن الخوف والذي يخلق إما الضعف والخنوع الأعمق وبالتالي الاستسلام المطلق أو النقمة والرغبة في الانسلاخ متى ما سمحت له الفرصة بذلك.
ويمكن أن يساق هذا الكلام على مستوى الجماعات، فالجماعات التي تعاني هذا القمع والكبت والتقييد تتجه باتجاهين، إما أن تكون جماعات منزوية على ذاتها خانعة ومسالمة ولا تحاول أن تزاحم الجماعات الأخرى على أي شيء، وإما ناقمة وحاقدة وغاضبة، لا تلبث أن تترقب الفرصة المناسبة للانقضاض من أجل تدمير الآخر والانتقام منه بشكل مباشر أو غير مباشر.
ولقد حاول مفكرون أمثال تزيفتان تودوروف في كتابه «الخوف من البرابرة: ما وراء صدام الحضارات»، أن يعالج أسباب الخوف -كما رآها- لدى المواطن الأوروبي والغربي تجاه الآخر وبالأخص العربي والمسلم. عن طريق تقديم مفهوم الحضارة باعتباره مفهومًا إنسانيًا لا يتعارض مع الهويات ولا يلغيها. كما كتب مفكرون عرب أمثال عبدالكبير الخطيبي في كتابه «نحو فكر مغاير» محاولة لتفكيك الشعور العربي بالخوف من الآخر عن طريق معالجة الهوس العربي بالميتافيزيقا وبوهم التراث المقيد للعقل العربي.
ويعالج أمارتيا صن في كتابه «الهوية والعنف» هذه الإشكالية من زاوية التعدد في الهويات وحرية الاختيار بعيدًا عن تحديد مسبق للفرد من قبل المجتمع، إذ يقول: «إن الاعتراف بالهويات المتعددة في العالم كله، والتي تتجاوز الانتماءات الدينية، حتى بالنسبة إلى أناس شديدي التدين، يمكن ببساطة أن يغير من العالم المضطرب الذي نعيش فيه».
إن إشكالية فهم الهوية نابعة -في نظرنا- من النظرة الضيقة في فهم الوجود الإنساني والذي تحاول الهويات الضيقة (الهويات القاتلة كما يسميها أمين معلوف) خلق غطاء أمام قدرتنا على تحسس مكاننا في هذا العالم. إن بعض الهويات الصغيرة حينما تحاول أن تكون هويات رئيسية للإنسان فوق هويته الإنسانية تخلق القلق والخوف من الآخر ومن ثم العداء له، وتولد رد فعل بالخوف المقابل. وهذه الإشكالية في الوعي بالهوية الحقيقية والرئيسة للإنسان تولد لديه حالة من التطرف الأهوج تجاه الهويات الأخرى، إما بشكل مباشر (صراع) أو غير مباشر (عنصرية وتمييز).
وربما نداءات اليمين المتطرف في الغرب تجاه المهاجرين تحمل مثالاً جيدًا على التطرف المتولد عن الخوف الناتج من تهديدات الهوية. فالتنوع الحاصل بسبب المهاجرين من الطبيعي أن يغير كثيرًا في تلك البلدان خصوصًا تلك التي تستضيف أعدادًا كبيرة منهم. فإلى جانب الخوف من تغير أساليب الحياة القديمة، يوجد الخوف من المستقبل المجهول لتلك البلدان. ويعمل هذا الخوف نحو الحصول على تطعيم ديني مسيحي، في عودة إلى الماضي والهويات الدنيا- التي يدفع هذا الخوف باتجاهها.
كما أن الغضب من جرائم المهاجرين، والغضب من عدم احترامهم للقواعد في البلد المستضيف، والغضب من حصولهم على العمل في تلك البلدان بسهولة نتيجة لانخفاض أجورهم بالنسبة لأجور المواطن الأوروبي والغربي يدعم بلا شك هذا الشعور.
المقدار الذي تستطيع المسيحية أن تضخه في مجتمعاتها من الخوف والغضب محدود فيما تظل المجتمعات الإسلامية قادرة على امتصاص كميات لا متناهية من تلك الثنائية.
وإذا انتقلنا إلى الغضب في محاولة لفهم طبيعته ودوره في خلق حالة من التطرف الجمعي، فأول ما سيخطر في بالنا هو الحالة التي خلقتها العولمة والرأسمالية العالمية من تقسيم للعالم على شكل غير عادل. من جنوب فقير وشمال غني. ومن دول الإنتاج ودول الأسواق، والتي لا تساهم في خلق تنمية في تلك البلدان بأي شكل من الأشكال، بل وتصر الدول الغنية في أحيان كثيرة على دعم أنظمة دكتاتورية واستبدادية وقمعية في بلدان العالم الثالث مما يولد إحساسًا بالضيم الذي يتبعه الغضب.
ويتوجه ذلك الغضب في اتجاهين أولهما تجاه تلك الأنظمة التي تستمر بالفشل في الإنجاز، والآخر في اتجاه عالمي على القوى الكبرى. هذا الغضب المليء باليأس والعجز يجد له تطعيمًا إسلاميًا يستدعي التراث والهوية باعتبارهما مصدرًا للحل، ويمثل كذلك عنصرين يجب أن يخاف المسلم والعربي من محاولة العولمة تبديدهما في الكيانات المدنية التي ولدتها الحضارة.
كما قد يكون غضبًا من انعدام العدالة والمساواة لدى تيار أو جماعة تجاه الأغلبية في مجتمع ما. (كما أشرنا سابقًا في ظلم الأقليات). فيولد لديها تطرف في الخطاب والتعامل مع الأغلبية، وعودة نحو التمسك بالهويات الضيقة لتلك الجماعة ومحاولة حمايتها من هيمنة الأغلبية. ويبدو واضحًا مدى التداخل والتبادل والتفاعل بين هذه الثنائية (الخوف والغضب) في حالات كثيرة فتظهر كل واحدة مستدعية للأخرى وخالقة لها. وتجدر الإشارة في نظرنا إلى أن القدر الذي تستطيع المسيحية أن تضخه في مجتمعاتها من ثنائية الخوف والغضب محدود في ظل تطور تلك المجتمعات، فيما تظل المجتمعات الإسلامية قادرة على امتصاص كميات لا متناهية من تلك الثنائية. فتوفر حاضنة أيديولوجية لذلك التطرف تساهم في نقله إلى طور الإرهاب.
وفي تلخيص ما سبق ذكره، يمكننا القول بأن ثنائية الخوف والغضب والتي ترتبط بأزمة في الوعي الإنساني تجاه قضايا جوهرية وإشكاليات فهمها والتعامل معها على امتداد التاريخ البشري تشكل معضلة ليس من السهل وضع حلول عملية ونهائية لها. وتظل أزمة الهوية وارتباطاتها بالعنف، بالإضافة إلى الظلم وانعدام المساواة -في تصنيفاتها السلطوية والعالمية (العولمة) والمجتمعية (الأغلبية)- ضمن علاقات جدلية معقدة التفاعل والتركيب. وتتداخل مع تركيباتنا النفسية البشرية وطبيعتنا الإنسانية، وهي لهذا السبب أزمة بكل ما للكلمة من معنى.