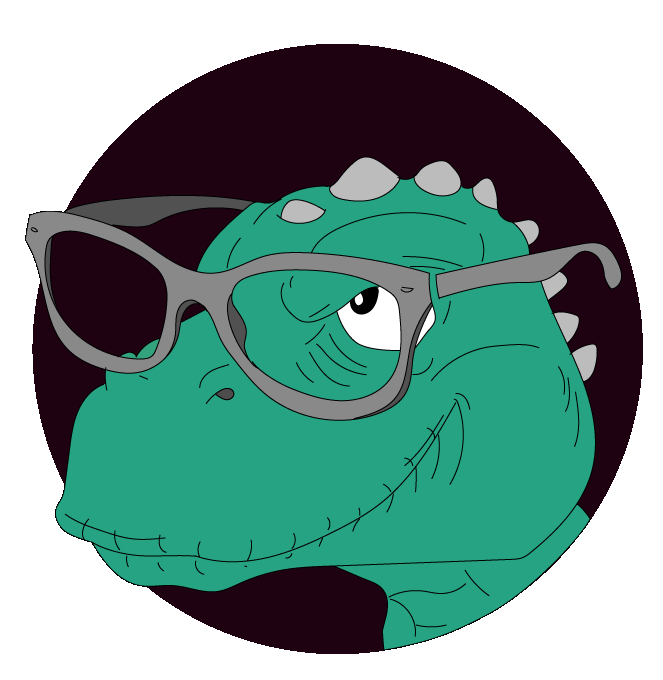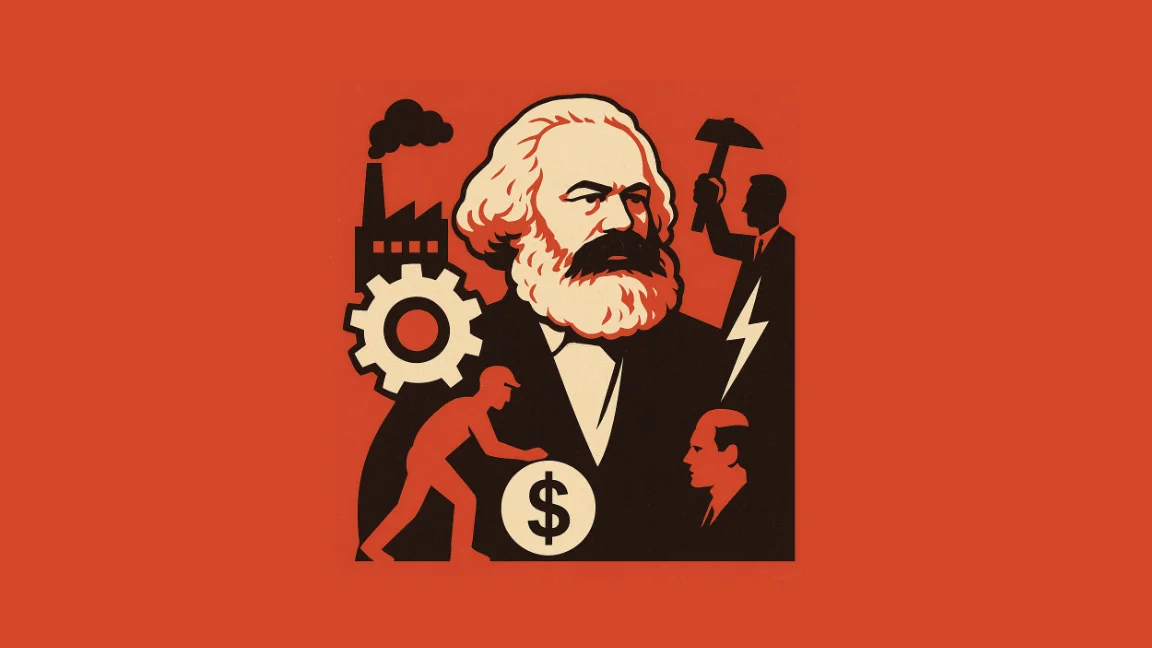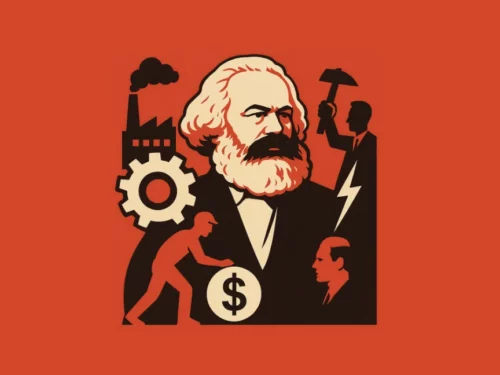من المؤسف أن لا يوجد لفظٌ أليق من «الماركسية» للدلالة على مجمل النظريات التي ارتبطت باسم كارل ماركس. وقد اشتهر عنه قوله إنه «ليس ماركسيًا» إذا كان المقصود بالماركسية بعض التأويلات المنحرفة لنظرياته في المادية التاريخية ونقد الرأسمالية. فالمشكلة أن ما ساهم ماركس في صياغته من نظريات ومناهج أوسع من أن يُختزل في لاحقة «ـية». ذلك أنه كان فيلسوفًا ومؤرخًا بالمعنى السياسي للاقتصاد، أي دارسًا لعلاقات الإنتاج والتجارة بالقوانين والأعراف والمؤسسات الإنسانية، وقد أثّرت أفكاره في ميادين شتّى: الاقتصاد، وعلم الاجتماع، والتاريخ، والأدب، والسياسة العملية.
وأقرب تشبيه يمكن استحضاره هو «الداروينية». فداروين لم يخترع علم الأحياء ولا علم الحفريات ولا علم الوراثة، غير أن أفكاره كانت أساسًا ثوريًا امتد أثره في تلك التخصصات. ومع ذلك، فإن كثيرًا من جوانب «الداروينية الكلاسيكية» كما وضعها داروين وأتباعه الأوائل قد روجعت أو رُفضت من قبل علماء ما زالوا يُحسبون على الداروينيين. فمنذ نشر أصل الأنواع ونشوء الإنسان، طوّر مئات بل آلاف العلماء والفلاسفة نظريات داروين وأغنوها بما يُعرف بـ«التوليف الحديث»، خصوصًا بعد اكتشاف علم الوراثة الجزيئي.
والأمر نفسه يصدق على الماركسية. فهي ليست مخططًا تفصيليًا لكيفية إنشاء الاشتراكية، ولا منظومة أخلاقية تبحث في «العدالة» على طريقة فلاسفة التنوير ومن جاء بعدهم، وليست دعوة مباشرة إلى العنف أو التمرد المسلّح. إنما هي قبل كل شيء تحليل علمي للمجتمع البشري وقوانينه، يكشف عن آليات تطوّره التاريخي. ومن صميمها نظريات الاغتراب والصراع الطبقي، التي تفسّر علل البؤس الإنساني وعقبات الازدهار البشري. وهذه هي المادية التاريخية: الفرضية القائلة بأن تطوّر المجتمعات مرهون ببنية «قوى الإنتاج»، وأن سمات كل مجتمع تعود في النهاية إلى طريقة تنظيم هذه القوى، وبأن الناس لا يتعاملون معها إلا كطبقات متمايزة ومتصارعة. ومن هنا ينبع الطابع الجدلي للنظرية.
وكما أن داروين لم يكن أول من تحدّث عن التطوّر، لم يكن ماركس أول اشتراكي. لكن الاشتراكية قبله كانت أقرب إلى نزعة أخلاقية مثالية، ذات جذور دينية أو طوباوية، تستند إلى ما هو «عادل» أو «منصف». وقد قضى ماركس وإنجلز معظم حياتهما يميّزان بين نظرياتهما و«الاشتراكيات الطوباوية» السابقة، حتى ألّف إنجلز كراسًا مطولًا خصيصًا لذلك. وكما أحدث داروين ثورة في نظرية التطوّر بطرحه «الانتقاء الطبيعي»، أحدث ماركس نقلة نوعية بإرسائه المادية التاريخية والجدلية.
وتُعلّمنا الماركسية أن ننطلق من الأساس المادي لفهم المجتمع: كيف يضمن البشر استمرار حياتهم؟ من خلال إنتاج الخيرات والخدمات الضرورية. كيف يتم هذا في المجتمع الرأسمالي؟ عبر استغلال عمل الطبقة العاملة، إذ يُضطر العمال لبيع قوّتهم كسلعة للطبقة المالكة. ونتيجة ذلك اغتراب العمال عن عملهم وعن حياتهم نفسها، مع تزايد متطلبات الإنتاج وتضاؤل قدرتهم على ضمان عيش كريم.
وعند الحديث عن الاقتصاد السياسي وتحليل أنماط الإنتاج، لا نجد منهجًا يضاهي الماركسية في قوته التفسيرية. ومع ذلك، فمن المفهوم أن يتحفّظ بعض الاشتراكيين أو الديمقراطيين الاجتماعيين عن تبنّي الماركسية بصفتها تركّز على «الصراع الطبقي» و«إسقاط» الطبقة الرأسمالية و«ديكتاتورية البروليتاريا»، وهي مصطلحات قد تُسمع في الأذن الحديثة أقرب إلى وصفة للعنف أو الاستبداد.
لكن ماركس قصد بها أمراً آخر. فالصراع الطبقي لا يعني بالضرورة المتاريس في الشوارع أو إعدام الأغنياء، بل يعني المنافسة الاجتماعية والسياسية المستمرة بين الطبقات: في المفاوضات على الأجور، والعرائض، والإضرابات، والتشريعات، وأحيانًا الثورات. وطبيعة هذا الصراع تتحدد بموازين القوى لا غير. إن الماركسية لا تبتدع الصراع، بل تكشف أنّه ملازم للرأسمالية.
وكلمة «إسقاط» لا تعني حتمًا العنف، بل التحوّل التاريخي الذي رافق جميع أنماط الإنتاج السابقة، من المشاعية إلى الرق، إلى الإقطاع، ثم الرأسمالية. وهذه التحولات لم تتم دفعة واحدة، بل عبر تراكم تغيّرات اقتصادية وتقنية وقانونية على مدى قرون، وكانت الثورات الكبرى جزءًا من سيرورة أطول وأعمق.
وأمّا «ديكتاتورية البروليتاريا» فهي من أكثر المفاهيم التي شُوّهت. فهي لا تعني إرهابًا دموياً ضد الخصوم ولا خنق الحريات، بل تعني ببساطة أن تنتقل السلطة السياسية من أيدي الطبقة المالكة إلى أيدي الطبقة العاملة، لفترة انتقالية يُعاد فيها تنظيم المجتمع على أساس الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج. وكما نعيش اليوم، واقعياً، تحت «ديكتاتورية» الرأسماليين، فإن الماركسيين يقترحون نقيضها: سلطة عامة تحفظ مصالح الأغلبية الساحقة.
لقد انتقد ماركس وإنجلز الاستدلالات الأخلاقية على الاشتراكية، لكونها لا تاريخية وتفتقر إلى أساس عقلاني، فالتغيّر لم يأتِ عبر المواعظ الأخلاقية، بل عبر الصراع الاجتماعي والسياسي. والماركسية لا تحرّض على العنف، بل تفسّر لماذا ينشأ، ومن أين يأتي، وكيف يرتبط ببنية الإنتاج.
وكما قبل علماء ما بعد داروين «الواقع التطوري» واشتغلوا ضمنه، يتقبّل الاشتراكيون بعد ماركس «الواقع المادي» للرأسمالية: أنّها قائمة على استغلال فائض القيمة وتغريب العمل. وأنّ الصراع الطبقي ملازم لها بحكم الضرورة. وأنّ نهاية النظام لن تأتي إلا حين تعي الطبقة العاملة ذاتها كطبقة وتتحرك باسمها.
وأمّا العنف، فلا ينسبه ماركس إلى الاشتراكيين ولا يجعله وصية لهم، بل يصفه كأثر شائع في التحولات التاريخية الكبرى، وغالبًا ما يكون صادراً عن المدافعين عن النظام القائم. والتاريخ الحديث ــ من حركة الحقوق المدنية في أمريكا إلى نضالات العمال في أوروبا وأمريكا ــ يبيّن أنّ العنف كان دوماً ردّ فعل من الدولة أو رأس المال ضد من طالبوا بحقوقهم، لا العكس.
إذن، فأن تكون ماركسيًا لا يعني أن تؤمن بالعنف أو الاستبداد، بل أن تعترف بالواقع القائم: أنّ هناك صراعًا طبقياً موضوعيًا، وأنّ مهمة الاشتراكيين هي إدراكه وتحديد استراتيجيات تجاوزه. فالحاضر والمستقبل تحكمهما الشروط المادية لا الخطب الأخلاقية. وكما قال ماركس في «الثامن عشر من برومير»: «يصنع الناس تاريخهم، لكنهم لا يصنعونه كما يشاؤون». ولئن أردنا أن نغيّر العالم، وجب أن نفهمه على حقيقته، من داخله، وأن نبني على واقعه. وهنا تكمن الماركسية.
نُشرت في Midwest Socialist.
احرص على أن يصلك جديد عن طريق الاشتراك في النشرة البريدية