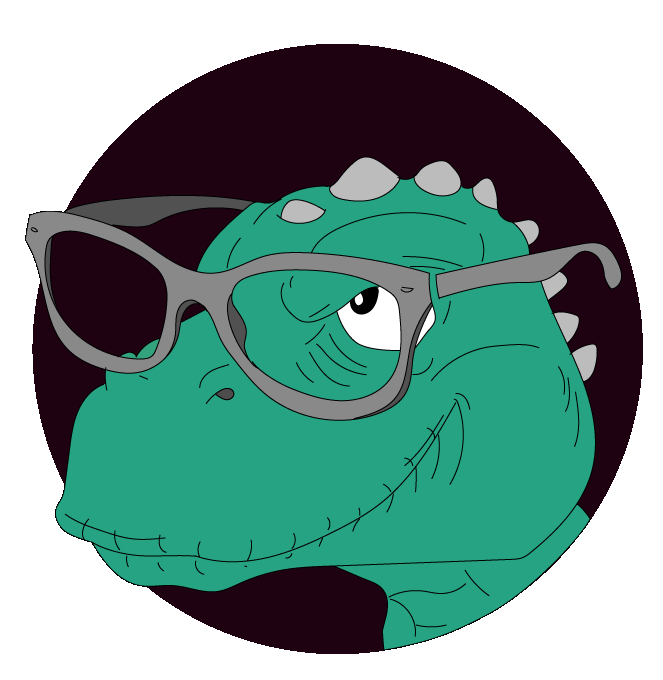تتسم العلاقات السعودية اليمنية بطبيعتها بالتعقيد والغموض. لن تجد أي تصريحات صريحة من أي من الجانبين. لم تتخذ السعودية موقفًا علنيًا متشددًا وواضحًا تجاه اليمن، ولن تتخذه على الأرجح، ولا اليمن كذلك. دبلوماسياً، يبدو كل شيء على ما يرام: تحافظ السعودية على موقف إيجابي لفظي تجاه اليمن، ويشيد به المسؤولون اليمنيون عمومًا. حتى عندما يمتلك زعيم يمني مشاعر وطنية صادقة، فإنه يتجنب أي تصريحات مسيئة أو اتهامية. وأصبحت متلازمة «الأشقاء» ترافق كل قول لهم. ومع ذلك، يدرك الجميع هذا الأمر. يوضح عبد العزيز الجباري، المستشار السابق للرئيس عبد ربه منصور هادي والذي لم يعد يشغل أي منصب سياسي، أن جميع الشخصيات السياسية اليمنية في الرياض تدرك تمامًا أنها تفتقر إلى أي سلطة حقيقية في اتخاذ القرارات بشأن بلادها، وأنها لا تمارس سيادة حقيقية، لكن لا أحد منهم يجرؤ على التصريح بذلك علنًا. يجد السياسيون اليمنيون، حتى أولئك الذين يتمتعون بروح وطنية صادقة، أنفسهم في موقف ضعف. من جانبها، لا تستطيع السعودية الإعلان عن نواياها بهذه الصراحة. وينطبق الأمر نفسه على ما تفعله الإمارات العربية المتحدة في السودان وليبيا: فالخطاب إيجابي، ولكن في الواقع، هناك تمويل ودعم للجماعات المتمردة.
سنتتبع في هذا المقال أجزاء كبيرة من التاريخ الطويل للتدخلات السعودية منذ قيام ثورة سبتمبر إلى يومنا هذا. ومن خلال هذا التاريخ، والاستشهاد ببعض آراء السياسيين والعسكرين، سنرى كيف أن كل هذا يدعم الأطروحة التالية : لا تطمح المملكة العربية السعودية إلى قيام دولة يمنية قوية ذات سيادة حقيقية، وقد ساهمت في عرقلة الجمهورية اليمنية منذ نشأتها بطريقة معينة تجعل اليمن دومًا تحت وصياتها ومرتكنة عليها. فبطريقة أو بأخرى، ينبغي علينا احتساب المسألة التالية: لماذا تسعى السعودية، بناءً على الوقائع التاريخية والمعاصرة التي سنتطرق إليها في هذا المقال، إلى تقويض قوة اليمن وزعزعة استقراره؟ فإذا قلنا إن لها مطامع فقط، فهذا لا يفسر الإصرار والمثابرة لمدة ستين سنة، فأي دولة ستسلّم للأمر الواقع بعد هذه الفترة الطويلة، خصوصًا أنها ستستنزف أموالًا طائلة طوال هذه الفترة الزمنية قد تجعل من أي مطامع عديمة الفائدة تقريبًا. مع ذلك، يمكن اعتبارها هدفًا ثانويًا ملحقًا بهدف رئيس. على أية حال، لنشرع في مجرى الأحداث ولنرَ إلى أين نصل.
منذ الثورة اليمنية السبتمبرية (1962)، دعمت السعودية الملكيين ضد الجمهوريين. وهذا أمر ليس مستغربًا البتّة من حيث هي مملكة. فنحن نرى في تاريخ الأمم الأخرى ذات الشيء، فحينما سعت فرنسا لتكون دولة جمهورية، وجِهت بشدّة من قبل الممالك المجاورة (النمسا وبروسيا) فيما عُرف بالحروب الثورية الفرنسية. واليمن، بحكم أنها أول دولة جمهورية محايدة لجيرانها، كان لا بد أن تثير هلع الممالك المجاورة، خصوصًا أن الجمهورية اليمنية كانت تمثل بنظرهم امتدادًا للنفوذ الناصري الثوري. تسبب دعم السعودية للملكيين بحرب أهلية استمرت قرابة ثماني سنوات، واعترفت السعودية أخيرًا بالجمهورية اليمنية في عام 1970. على أن الأمور لم تقف عند هذا الحد، فاعتراف السعودية كان نتيجة أمر واقع. ولهذا كان على السعودية أن تبحث عن حل آخر، تمثّل في الاحتواء الناعم بدل المواجهة. فأخذت تشكل شبكة زبائنية عن طريق تقديم أموال لرؤساء القبائل وبعض القادة العسكريين والسياسيين بُغية منع تشكّل دولة يمنية قوية، وذلك لمخاوف في أذهانهم تمثّلت في أن اليمن القوي يشكّل خطرًا وجوديًا عليهم.
وفق السرديات السائدة اليوم في اليمن، تقريبًا من كل الأطراف، السعودية تورطت في اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي (11 أكتوبر 1977) عبر استخدام القبيلة (عبد الله بن حسين الأحمر) وعسكريين (الغشمي وعلي عبد الله صالح). يُمثِّل الحمدي في المخيال اليمني المعاصر رمزًا للرئيس المثالي، وهو لا يُعتبر رئيسًا مثيرًا للجدل، فهناك إجماع شعبي واضح على نزاهة الحمدي. ويُحكى أنه مات مديونًا. إذا كان هناك رئيس واحد أجمع اليمنيون على حبه، فسيكون الحمدي. حَكم لفترة لا تتجاوز ثلاث سنوات وثلاثة أشهر وثمانية وعشرون يومًا (13 يونيو 1974 حتى 11 أكتوبر 1977)، لكنّه قام بالعديد من الإنجازات الهامة والهائلة في البنية التحتية، وبناء التعاونيات، والإصلاحات السياسية والديمقراطية بُغية تصحيح مسار الثورة الذي كان قد بدأ في الانحراف. وبذكر ذلك، فإن ثورة سبتمبر اليمنية، التي كان هدفها الرئيس التخلص من نظام الإمامة وبناء دولة جمهورية ديمقراطية قائمة على المساواة بين كل فئات المجتمع، استولت عليها القبيلة؛ إذ تغلغل مشائخ القبائل بشدة في مفاصل الدولة بعد الثورة، وفي مجلس الشورى (كان حينها بمثابة البرلمان)، حيث كان المشائخ يمتلكون أغلبية المقاعد، وقد حازوا على هذه المقاعد بطرق ملتوية وليس عبر انتخابات مباشرة وديمقراطية حقيقية. وأهم ما كان يسعى إليه الحمدي، وهذا كان أحد أسباب اغتياله، هو أنه أراد تقويض سلطة ونفوذ القبيلة المهيمنة على الدولة (الشبكة الزبائنية السعودية)، وبسط نفوذ الدولة في كل أرجاء اليمن الشمالي، وسيادة القانون. إنّ ما حدث بعد الثورة هو إعادة إفراز طبقية جديدة يكون في هرمها مشائخ القبائل بدلًا من إلغاء الطبقية وبناء مجتمع على أساس المواطنة المتساوية. وقد تجلّت بوضوح هذه الهرمية الجديدة في عهد الرئيس عبد الرحمن الإرياني (الرئيس السابق للحمدي، 1967 إلى 1974) عن طريق استحواذ مشائخ القبائل على أغلب مقاعد مجلس الشورى كما قلنا. والحق أن الحمدي لم يسعَ قط لأن يشكّل خطرًا على السعودية أو أن يضرّ بمصالحها بأي شكل من الأشكال، وقد حاول جادًا بناء علاقة طيبة مع السعودية، على أن لعب المُخيّلة السعودية كان أقوى من الواقع. فقد ترجمت مخيّلة السعوديين سعي الحمدي إلى بناء يمن مدني قوي ذي سيادة، من خلال تقويض دور القبيلة فيه، وتوحيد شطري اليمن، وتسليح الجيش، وإصلاحات ديمقراطية واقتصادية عميقة؛ إلى خطر وجودي محدق. فالقبيلة كانت يد السعودية، والوحدة اليمنية تعني قوة مضاعفة لليمن، ومسألة محاولة اليمن الحصول على أسلحة روسية تعني ترسيخ السيادة. جاءت الإشارة، في سياق التقرير السنوي الذي أعدته السفارة البريطانية في صنعاء عام 1977، إلى مسألة تسليح اليمن على النحو الآتي: «السعوديون من جهتهم ليست لديهم الرغبة في رؤية جيش يمني قوي وكبير في بلد مجاور. وبالتالي فإنّ إمدادات السعودية لليمن بالأسلحة الأميركية والفرنسية كانت شحيحة جدا وتخضع لمراقبة مشرفين من السعودية».
يتحدث عبد العزيز الجباري، في مقابلة له في بودكاست «اليمن بودكاست»، عن هذا الهاجس السعودي، هذا الخوف الذي يراه غير مبرر من اليمن، ويقول إن على السعودية أن تدرك أن لا خطر عليها من اليمن، وقد أثبت أكثر من ستين عامًا هذا الأمر، وأنه أمر متخيّل لديهم. على أنه لا يدرك أن هذا الهاجس ليس في كون اليمن تسعى للإضرار بالسعودية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بل في النموذج الجمهوري الناجح. فالنموذج الجمهوري، من حيث هو نموذج، يُترجَم في مخيلتهم خطرًا وجوديًا من حيث هم مملكة.
في عهد الحمدي، كان يبدو أن اليمن يتجه ليكون نموذجًا جمهوريًا ناجحًا ذا سيادة، فارتعدت فرائصهم. ونرتكز على هذا القول على ثلاث ركائز: أولًا، تاريخ الأمم الأخرى كما ذكرنا عن تاريخ فرنسا. ثانيًا، الإعلام الشعبي، الذي تكون فيه المخايل أوضح، وتمثّل في البودكاستات السعودية التي تروج للأطروحة التالية: الجمهوريات في العالم العربي مستوردة، وبحكم أنها كذلك فشلت، في حين أثبتت الممالك نجاحها. ثالثًا، لا يبدو أن أي أطروحة أخرى تنسجم أو تفسر الوقائع بشكل أفضل.
اندلعت حرب صيف عام 1994 بين شطري اليمن، إثر خلاف سياسي حادّ تفاقم بين علي عبد الله صالح، الذي تولّى حكم اليمن ثلاثة وثلاثين عامًا منذ عام 1978 حتى عام 2012، وعلي سالم البيض، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، وأحد أبرز قادة دولة الجنوب سابقًا وشريك الوحدة ثم نائب رئيس الجمهورية عقبها. ويقال إن السعودية دعمت قوى انفصالية بشكل غير مباشر. وهذا يتسق تمامًا مع موقفها قبل الوحدة، حيث حاولت ثني الأمين العام للحزب الاشتراكي في جنوب اليمن عن الدخول في الوحدة وفي سياق سابق، يرجح أن أحد الأسباب الرئيسة لاغتيال الحمدي كانت مسألة سعيه للوحدة والاقتراب من تحقيقها. وبعد حرب أربعة وتسعين، واصلت السعودية دعم شخصيات قبلية وسياسية، ولعبت أيضًا دور الوسيط في الخلافات الداخلية.
بين عامي 2009 و2010، تدخلت عسكريًا بشكل محدود خلال الحرب السادسة على الحوثيين، وهم جماعة مسلحة كانت مستقرة في صعدة، مؤسسها حسين بدر الدين الحوثي الذي قتل في 2004 على يد الجيش. وزعيمها الحالي، أخوه عبد الملك الحوثي. وتحمل أُدلوجة إسلاموية شيعية ومدعومة من إيران، وترفع شعار «الموت لأمريكا ؛ الموت لإسرائيل؛ اللعنة على اليهود؛ النصر للإسلام». وفي عام 2011 اندلعت ثورة الشباب السلمية، فتدخلت السعودية بقوة عبر رعاية «المبادرة الخليجية»، والتي أفضت في نهاية المطاف إلى تنحي علي عبد الله صالح ونقل السلطة إلى نائبه عبد ربه منصور هادي. وخلال هذه المرحلة، لعبت السعودية دور الضامن الإقليمي للعملية الانتقالية، مع استمرار نفوذها داخل المؤسسة السياسية والعسكرية اليمنية.
في 21 سبتمبر 2014، سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، واحتجز الرئيس عبده ربه منصور هادي في قصره إلى أن تمكن من الهرب إلى عدن (جنوب اليمن) في فبراير 2015. بعد ذلك أعلن هادي رفضه للإنقلاب الحوثيين، وسعى للحصول على دعم دولي واستعادة الشرعية الدستورية. وبعد محاولة الحوثيون التقدم نحو عدن، أصبح وجود هادي في اليمن خطيرًا، فقد كانت قواته محدودة القدرة، مما اضطهره إلى مغادرة البلاد إلى السعودية واستمر في ممارسة السلطة من هناك.
وفي مارس من نفس العام، أطلقت السعودية تحالفًا عسكريًا للتدخل العسكري في اليمن تحت شعار «دعم الشرعية» ومنع سيطرة الحوثيين على الدولة. شمل التدخل ضربات جوية واسعة، و«دعمًا» للقوات الموالية للحكومة، وتدخلًا سياسيًا وأمنيًا عميقًا، ما جعل هذه المرحلة الأكثر كثافة على الإطلاق في تاريخ التدخلات السعودية، واستمرت هذه التدخلات إلى اليوم. وفي حقيقة الأمر، فإن الدعم العسكري للشرعية اليمنية لم يكن دعمًا حقيقيًا، فقد حرصت السعودية على ألا يمتلك الجيش اليمني إلا الأسلحة الخفيفة، ووفقًا للواء محسن خصروف (الرئيس السابق لدائرة التوجيه المعنوي في الجيش اليمني) لم يزد التحالف الجيشَ الوطني بأي أسلحة نوعية من شأنها أن تحدث فارقًا في موازين القوى: لا أسلحة ثقيلة، ولا مدافع ثقيلة، ولا دبابات، ولا قواعد صاروخية… إلخ. وقد استهدفت في ضرباتها الجوية في البدء بعض مخازن الأسلحة الثقيلة في صنعاء، بحجة خشية استعمالها من قبل الحوثي.
وفي 7 يوليو 2015، استهدف التحالف العربي بقيادة السعودية اللواء 23 ميكا في منطقة العبر بمحافظة حضرموت، وهو لواء تابع للجيش اليمني الشرعي، والذي من المفترض أن يدعمه التحالف. تُعرف هذه الحادثة اليوم بـ«حادثة العبر»، والتي راح ضحيتها اللواء أحمد يحيى غالب الأبارة وعشرات الضباط الآخرين. وتبعت هذه الحادثة حوادث أخرى لاستهداف الجيش اليمني الشرعي، كحادثة العلم الشهيرة. وقد أرجع المتحدث باسم التحالف، وهو سعودي، هذه الحوادث إلى أخطاء، في حين أن الأمر واضح للعيان أنه استهداف متعمّد. ولم يتم التحقيق في أمرها إطلاقًا.
ويرجّح كثير من السياسيين والعسكريين أن الإمارات تحديدًا هي من قامت بتلك الضربات الجوية التي استهدفت الجيش اليمني أكثر من مرة، على أن تواطؤ السعودية أمر مؤكد، فمتحدث التحالف العربي، الذي هو سعودي، كان هو من يصعد ويبرّر كل هذه الحوادث باعتبارها أخطاء. مما يشير إلى أنه حتى لو كانت الإمارات هي من تنفذ المهمة القذرة، فإن الأمر كان يصب ويخدم، أو يتفق، مع أجندة السعودية إلى حد كبير، خصوصًا أنها لطالما حرصت على إضعاف الجيش اليمني خلال تاريخ تدخلاتها.
أما الإمارات فقد كان لها أغراض أخرى: فالجيش الوطني يجب أن يبقى ضعيفًا، لكن فقط لكي تصنع جيوشًا أو مليشيات موازية له لا تتبع الجيش الوطني. فقد عملت على دعم وتشكيل وتسليح المجلس الانتقالي، ومليشيا طارق، وفي البداية مليشيات الإخوان وإسلاميين آخرين في تعز. ولهذا لم يكن يصب في خدمتها أن يقوى الجيش الوطني، ولا أن تتحرر صنعاء من الحوثي. ومآربها طموعية استعمارية صرفة، ضمن خطة إمارتية إسرائيلة كبرى، لا تشمل اليمن فحسب، بل العديد من دول المنطقة.
يتبع …
لا غنى عن قراءة الجزء الثاني: