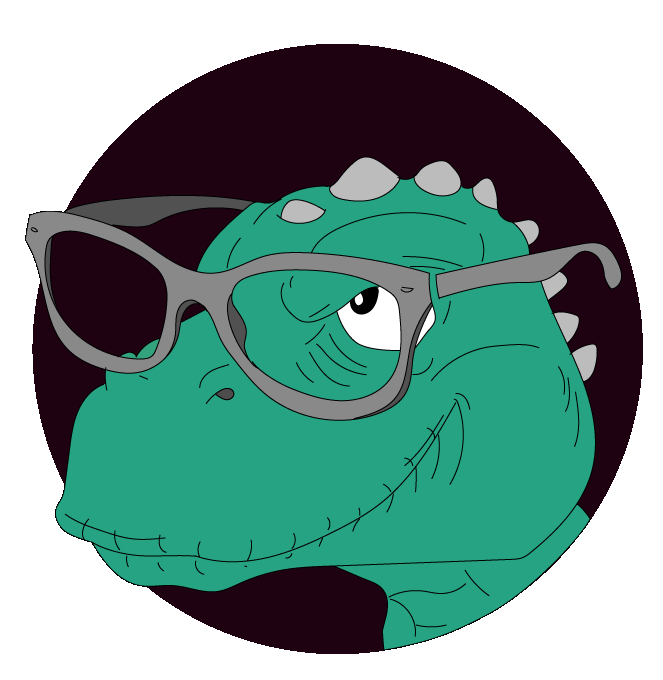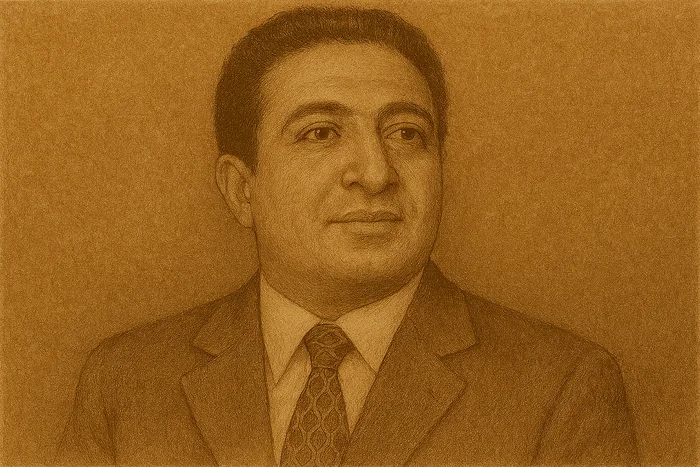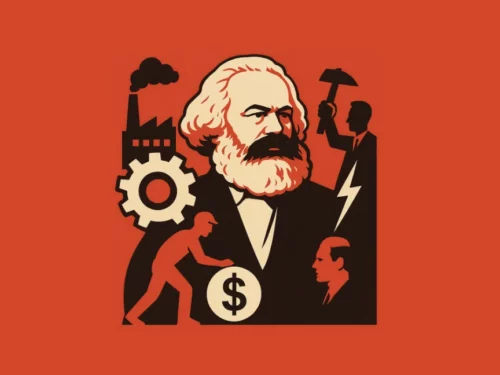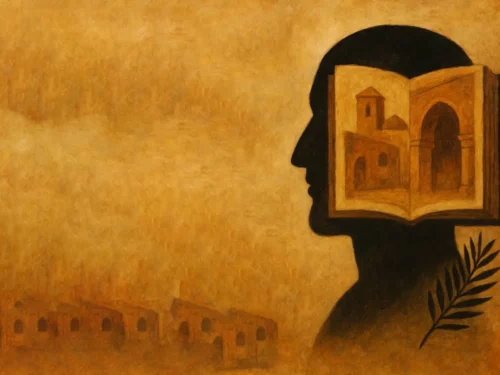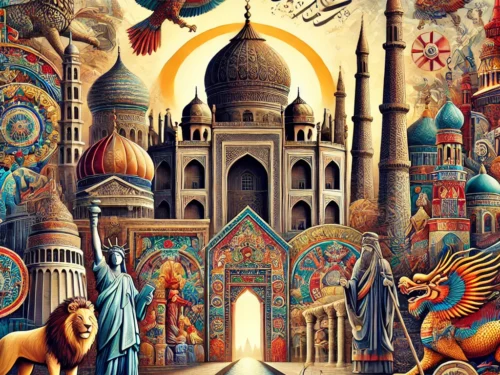قلب ضياء السعيدي في مقابلة له على منصة بودوكست سعودية، التاريخ رأسًا على عقب، يقول إنه لا يؤمن بسرديات البطولة، لكنه في الحقيقة يؤمن بها. فما فعله هو قلب الأمور: بدل التخلي عن سرديات البطولة، حوّل الجلاد إلى ضحية والضحية إلى جلاد، البطل شريرًا والشرير إلى بطل. وهذا أمر يسير يستطيع أي شخص فعله؛ فكل فرد يمكنه أن يسرد تاريخ أي أمة وأي شعب بالشكل الذي يريحه. نستطيع إعادة قراءة تاريخ فرنسا بطريقة تجعلنا نرى أن الجمهورية كانت فكرة سيئة المنبت، تمامًا كما فعل السعيدي مع تاريخ الجمهورية اليمنية الحديث. فضلًا عن أنه سرد التاريخ بشكل غلط، حتى في ترتيب الأحداث، فقدم وأخر وغلط في الأسماء، وتجاهل بعض النقاط الهامة، وشوه الشخصيات وشيطن كل الشخصيات التقدمية في التاريخ اليمني الحديث. ولكن هذا ليس حديثنا، فأنا لا أكتب هذه المقالة كتصحيح تاريخي، بل كتصحيح مفاهيمي فلسفي.
السعيدي يتبنى فكرًا مناهضًا للجمهورية علنًا وبكل وقاحة، فردّ كل نضالات اليمنيين من أجل الجمهورية هباءً منثورًا. كل هذا لصالح إثبات فكرته القائلة إن الجمهورية فكرة «مستوردة»، وبحكم أنها كذلك لم تتلائم مع البيئة المحلية القبلية. وهو يطبعها بكلمة «مستوردة» لتهيئة الشعب، الذي طُبّع على خشية الأفكار المستوردة من قبل القوى الظلامية، ليمهد بذلك لفكرته اللاحقة. يضيف أيضًا أنها — أي الجمهورية — فكرة «يسارية»، فرضها اليسار اليمني على القبيلة، وجعلهم يهابون معارضتها خشية وصفهم بـ «الرجعيين». وينشد دولة «رئاسية مشيخية»، يحكم فيها شيخ غير منتخب يتدرج في السلم المشيخي للوصول للحكم بدلًا من رئيس مدني منتخب.
لن أصف ضياء السعيدي بـ«الرجعي»، على أني سأجعله يرى ويحكم على نفسه أنه كذلك، فهذا ليس إهانة ولا هجومًا ولا شخصنة، بل حقيقة ستتضح باكتمال هذه المقالة المتواضعة.
مشكلة السعيدي أنه يريد أن يقرأ الأمور بشكل تاريخي صرف من زاوية إمامية قبلية. أولًا، كما أسلفتُ، إن أي قراءة لأي تاريخ بلد يمكن أن تتم من أي زاوية تلائم فكر القارئ. فلو كان رجعي العقل، قال ذات الشيء. كما هو المثال المضروب سابقًا حول الجمهورية الفرنسية، خصوصًا وأن تاريخها كان مليئًا بالاضطرابات والتقلبات الشديدة، لدرجة أنك لو وقفت في لحظة ما من تاريخها بعد الثورة، لجاز لك أن تقول فيها ما قُلت في اليمن: أن الجمهورية فكرة «فاشلة»، ولا تصلح لفرنسا. لكن لأننا نعيش في المستقبل، فإننا نرى أمام أعيننا تتويج نجاح هذه الفكرة المذهلة.
لكي تتضح الصورة أكثر، لا بد من إعادة سرد تاريخ فرنسا، ولو بشكل مقتضب، لندرك المراحل الطويلة والمتقلبة التي كانت ضرورية لينضج فيها وعي الجمهورية:
في 14 يوليو/تموز 1789، اندفع الشعب الباريسي لاقتحام سجن الباستيل، الذي كان رمزًا لاستبداد الملكية المطلقة والسلطة التعسفية. وفي عام 1792 أُعدم الملك لويس السادس عشر، وقامت الجمهورية الفرنسية الأولى، وبدأت أيضًا في نفس العام الحروب الثورية الفرنسية، التي كانت في البداية مع النمسا وبروسيا. وفي نفس العام دخلت فرنسا في ما يسمى «بعهد الإرهاب» بقيادة روبسبير، الذي قام بتصفيات دموية واسعة بالمقصلة لمعارضيه. في السنة التالية توسعت الحرب مع أوروبا لتشمل ما يسمى بـ «التحالف الأول»، الذي ضم بالإضافة إلى الدولتين السابقتين، بريطانيا وإسبانيا وهولندا وبعض الدويلات الإيطالية والألمانية. صارت الممالك الأوروبية، التي تخشى تفشي فكرة الجمهورية في أوروبا، في مواجهة فرنسا الجمهورية. حرب مع الخارج، وإرهاب في الداخل كان يقوم به روبسبير لمعارضي الثورة. وفي صيف تلك السنة أُعدم روبسبير بسبب رغبة روبسبير باستمرار حالة الثورة الذي كان يراها البعض استمرار للإرهاب الثوري فخافوا أن يطالهم الأمر. بعدها ابتدأ عهد الإرهاب الأبيض (1794 – 1795) ضد اليعاقبة (تيار روبسبير الجمهوري)، قام بها طيف من الفئات (عناصر ملكية وبرجوازية وخصوم آخرين لليعاقبة).
تُسمى الفترة من عام 1792 إلى عام 1799 «فترة فرنسا الثورية»، وقد اتسمت هذه الفترة بحرب دائمة. وكان صعود نابليون في 1799 ثمرة لهذه الصراعات. ومع صعود نابليون، عادت فرنسا مرة أخرى إلى نظام السلطة المطلقة للحاكم بمظهر يتخلله عناصر جمهورية زائفة، وأعلن نابليون نفسه إمبراطورًا على فرنسا. وبدا أن حلم الجمهورية قد تلاشى إلى الأبد. وبدأت فرنسا حقبة جديدة من الحروب عُرفت بالحروب النابليونية (1803 – 1815) التي انتهت بهزيمة نابليون في معركة واترلو الشهيرة في يونيو/حزيران 1815. وبذلك عاشت فرنسا 23 عامًا من الحرب المتواصلة.
الآن تخيلوا معي، ماذا حدث بعد نهاية عهد نابليون؟ هل عادت الجمهورية؟ كلا، بل أُعيد آل بوربون مرة أخرى للسلطة، وتقلد الحكم الملك لويس الثامن عشر، شقيق الملك لويس السادس عشر الذي أُعدم من قبل الثوار في بداية الثورة كما أسلفنا الذكر. هذه الفترة عُرفت بالمملكة «المستعادة»، وكانت – وعلى خلاف المملكة السابقة – ملكية دستورية، لأن الثورة كانت في أساسها تتجه نحو الملكية الدستورية. ولأن العودة إلى ما قبل الثورة مستحيل عمليًا، كان أي ملك يجب أن يعلن مناصرته للثورة، إذ أن أي عداء علني لها يعني عداءً للشعب.
توفي الملك لويس الثامن عشر في 16 سبتمبر/أيلول 1824 وخلفه شقيقه الأصغر شارل العاشر، الذي كان آخر ملوك آل بوربون وآخر ملوك المملكة المستعادة، قبل أن تطيح به ثورة يوليو/تموز 1830. لهذه الثورة أسباب كثيرة، مثل إلغاء الحريات ومحاولة استعادة ملامح النظام الملكي المطلق البائد، عن طريق تعزيز سلطة الكنيسة والأرستقراطية. ونُصب بدلًا عنه الملك لويس فيليب، ومن نتائج الثورة ترسيخ الملكية الدستورية وتقرير أن الملك يستمد سلطته من الشعب لا من الحق الإلهي.
لم يتوقف الأمر عند هذا، ولم تمت فكرة الجمهورية، إذ إن الفكرة ما إن تولد لا تموت. ففي عام 1848 وُلدت الجمهورية الثانية بعد ثورة فبراير/شباط 1848 التي أطاحت بملك فرنسا لويس فيليب. لكنها لم تستمر سوى أربع سنوات فقط، إذ انقلب لويس نابليون بونابرت (ابن شقيق نابليون الأول) ليصير إمبراطورًا باسم نابليون الثالث سنة 1852.
بعد هزيمة فرنسا أمام بروسيا، تأسست الجمهورية الثالثة (1870 – 1940)، وكانت الأطول عمرًا بين الجمهوريات السابقة. انتهت الجمهورية الثالثة بعد اجتياح ألمانيا النازية لفرنسا وقيام نظام فيشي. وبعد الحرب العالمية الثانية، قامت الجمهورية الرابعة (1946 – 1958)، أما الجمهورية الخامسة فقد أُسست على يد شارل ديغول سنة 1958، وما زالت قائمة إلى اليوم. أي أن فرنسا عرفت خمس جمهوريات متتابعة منذ 1792 حتى اليوم، أي 166 سنة للوصول إلى الجمهورية الخامسة الأكثر استقرارًا.
كان هذا السرد التاريخي المقتضب جدًا لتاريخ فرنسا حجتي المضادة للدعوى القائلة إن 63 عامًا منذ ثورة 26 سبتمبر اليمنية كافية لإثبات فشلها. إذ بالنظر إلى تاريخ فرنسا يتضح أنه لا يمكن الحكم بعد 63 سنة فقط أن الثورة السبتمبرية فاشلة لا محالة.
لنأخذ هذه التجربة الفكرية، لنفترض إمكانية العودة إلى الوراء بالزمن عبر آلة زمن، وأنه متى عدنا إلى الوراء بالزمن لا يمكننا تذكّر ما بعد تلك النقطة إطلاقًا. فإذا عدنا إلى بعد 63 سنة منذ قيام الجمهورية الفرنسية الأولى، نجد أنفسنا في زمن نابليون الثالث، أي عام 1855، دون أي ذاكرة عما سيجري بعد هذه النقطة المرجعية. وإذا كنا نفكر بمنطق السعيدي، لحكمنا أن فكرة الجمهورية، فكرة مثالية، لا تتناسب مع واقع فرنسا. هذا بالضبط ما يقوم به السعيدي: يحاول أن يحكم على المستقبل منذ الآن.
ما تثبته هذه التجربة الفكرية هو أننا لا نستطيع أن نحكم من خلال تعدد تجاربنا الفاشلة في الماضي أن الفكرة لا تصلح. أعتقد أن هذه التجربة الفكرية، عبر استعراض تاريخ فرنسا، كافية لدحض حجة الفشل لضياء. أي أنه لا يمكننا أن نتنبأ بحتمية فشل الجمهورية بناءً على تجارب سابقة ممتدة زمنيًا. الزمن ليس معيارًا للفشل.
أما بالنسبة لحجة «الاستيراد»، فإن كون الفكرة مستوردة ليس بالضرورة دليلًا على عدم توافقها. لقد بنى السعيدي فكرته أن الجمهورية فشلت لأنها مستوردة، ودليله الزمن، الثلاثة وستون عامًا الماضية، والحرب الحالية. إنه من خلال الزمن، أجبر نفسه على إيجاد عذر لفشل الثورة المزعوم، وقد تجسّد هذا العذر بعدم انسجام الجمهورية كفكرة مع واقع اليمن كما يصور. على أننا قد أثبتنا مسبقًا، من خلال تجربتنا الفكرية، أن الزمن ليس حجة كافية. مع ذلك، لا ضير أن نعزز حجتنا المضادة بحجة أخرى: يدعي السعيدي أن البيئة اليمنية في أغلبها بيئة قبلية، وأن الجمهورية فكرة متناقضة تمامًا مع هذه البيئة. وبالرغم من كوني أشك أن البيئة اليوم في أغلبها قبلية (لأننا بهذا نهمل أن الواقع اليوم فيه ملايين الناس الذين تمدنوا، ليس في تعز وعدن فحسب، بل في كل مكان، ولو كنّا نمتلك بيانات واضحة، لنصدمنا بكمية الشعب المتمدن)، إلا أني سأنجر وراءه في هذا القول. المسألة الآن تكمن في أن الجمهورية لا تتوافق مع البيئة المحلية، وأنها فشلت كونها تحاول فرض قيمها على بيئة غير مؤاتية، فبدل أن نخلق نظام حكم يتوافق مع البيئة وينسجم معها، حاولنا تطويع فكرة مستوردة قسرًا على الواقع، وهذا ما أفضى لفشل الجمهورية، وللحرب اليوم. إذًا المسألة هي مسألة انفصام بين الفكرة والواقع. فالأسئلة التي تطرح نفسها: هل يجب فعلًا أن تنسجم الفكرة مع الواقع؟ وإذا كانت الفكرة منسجمة مع الواقع، هل يمكننا أن نسمّي هذا تغييرًا؟ ما هي الثورة؟
الفكرة الناشئة التي تقود للثورة لا تكون منسجمة مع الواقع إطلاقًا، في حقيقة الأمر (ولست هنا أتحدث من منطلق هيجلي بحت، ولو بدا الأمر كذلك، فتركيزي على الفكرة هنا، لا ينفي الشروط المادية بالضرورة، ولا يهمل في ذات الوقت الفكرة، فأنا أرى بتفاعل المادة والفكرة، بكل ما يحمله وزن «تفاعل» في اللغة العربية من دلالة على علاقة تتجه من طرفين بشكل متبادل، لهذا فأنا أقول بالهيجلية الماركسية، على أني أركز في هذا المقالة على جانب واحد للتفاعل لما يقتضيه الأمر). تنشأ الثورات عن هذا التوتر بين الفكرة الناشئة والواقع. حينما ظهرت فكرة الحرية والمساواة والأخوة في فرنسا، كانت هذه الأفكار في صدام مع الواقع، لم تكن منسجمة معه على الإطلاق. هذا الصدام بين الفكرة والواقع هو ما قاد للثورة الفرنسية، وبالتالي الجمهورية الفرنسية. لا تكون الفكرة مؤاتية للواقع، بل على النقيض، تكون منافية له بشكل يخلق توترًا يقود في نهاية المطاف إلى ثورة تغيّر الواقع. على أنها لا تمحو الماضي تمامًا، بل تنفي ما فيه من قصور وتخلّف. فالثورة الفرنسية — على سبيل المثل — لم تلغِ فكرة الدولة والسلطة، بل أغفلت شكل الدولة الملكية. العلاقة بين الفكرة والواقع هي دائمًا علاقة جدلية، لا علاقة انسجام وتوافق كما يدعي السعيدي. إذا ما حاول المرء الإنسجام مع الواقع، فإنه — في حقيقة الأمر — لا يقوم بشيء، لا يصنع أي تغير، لا يصنع أي ثورة؛ ذلك أنّ الثورة تعيد تشكيل كل شيء: وعينا، تفكيرنا، عاداتنا؛ بل حتى البنية الاجتماعية. قضت الثورة الفرنسية على امتيازات الأرستقراطية ورجال الدين. فالنبيل لم يعد يمثل أي شيء، ولم يعد يمتلك أي امتيازات تُذكر، عاد مواطنًا عاديًا تمامًا؛ وفقد رجال الدين سلطتهم وسيطرتهم الإقطاعية على الأراضي. الثورة لا تتماشى مع الواقع، بل تغيّره.
إن خطأ السعيدي هو في اعتقاده أن الجمهورية هي الفكرة التي كانت تنافي الواقع، ولكن هذا ليس صحيحًا تمامًا. الجمهورية لم تكن إلا التوليفة، نتيجة حل التوتر بين الفكرة والواقع. فما هي إذًا هذه الفكرة التي أفضت في نهاية المطاف إلى الجمهورية من حيث هي توليفة؟ في حقيقة الأمر، كان هناك ثلاثة عناصر رئيسة لهذه الفكرة: التحرر من الاستبداد، العدل، والمساواة. وقد كان الواقع الإمامي منافيًا لهذه العناصر، فالنظام الإمامي يقتضي الاستبداد؛ لأنه حكم يكرّس السلطة المطلقة للفرد على الجماعة. فالجبايات والضرائب التي كانت تفرض على الفقراء والمزارعين، حتى على الأراضي التي لم تُزرع، كانت تصب في مصلحة طبقة طفيلية عليا، ولا يتلقى الشعب أي خدمات حقيقة مقابِل ما يدفعه لتلك الطبقة الحاكمة، في غياب واضح للعدل. مجتمع استند في أساسه على الطبقية: سادة وقضاة في الأعلى، وعبيد في أسفل الهرم الاجتماعي، مما يعني غياب المساواة. ونحن هنا لا ننحاز ضد الإمامة، ولعل رأي شخص غير يمني عن عهد الإمامة يجعلكم ترون واقع الحال بعدسات محايدة: أشار الأديب المؤرخ اللبناني المسيحي أمين الريحاني، في كتابه «ملوك العرب»، إلى حالة الجهل في الشطر الشمالي في اليمن إبّان رحلته إليها:
«أما ضعف الزيود فهو في جهلهم الكثيف وتقهقرهم، لا بالنسبة إلى الأوروبيين، بل بالنسبة إلى المصريين والسوريين والعراقيين. كأنك في السياحة في تلك البلاد السعيدة قولًا وتقليدًا تعود فجأة إلى القرن الثالث للهجرة، لا مدارس، ولا جرائد، ولا أدوية، ولا أطباء، ولا مستشفيات في اليمن»1.
لهذا فإن الفكرة (التحرر من الاستبداد، العدل، والمساواة) بعناصرها الثلاث، هي ما كانت في توتر مع الواقع. وأي توتر بطبيعة الحال يفضي في نهاية المطاف إلى ثورة. إن الثورة آلية تقدمية تفضي إلى انحسار التوتر عن طريق تقديم توليفة. فالتوتر يدفع لإيجاد توليفة، والتي تتجلى عن طريق الثورة. هذه التوليفة هي «الجمهورية». وهي فكرة تستند على حكم الجمهور (الشعب)، أتت كحل للتحرر من الاستبداد. وترتبط بشكل وثيق مع مفاهيم أخرى كالديمقراطية (الآلية التي تمكّن حكم الجمهور)، والعدالة، وتنسجم مع المساواة، ومفاهيم أخرى كالمواطنة والمدنية، إلخ… ومن هذا المنطلق، يمكن تفسير الصراعات الممتدة على مدى 63 سنة منذ قيام الجمهورية، ليس بوصفها دليلًا على فشل الجمهورية، كما يذهب السعيدي، بل على النقيض من ذلك، باعتبارها استمرار للصراع بين أطروحة الإمامة (الاستبداد، الظلم، الفوارق الطبقية) وبين النقيضة (التحرر من الاستبداد، العدالة، المساواة)، أي أننا ما زلنا في طور الثورة، في طور الصراع. مشاكل اليمن المتكررة ناتجة عن كون الاستبداد لم يزل تمامًا بعد، والظلم ما زال قائمًا، والفوارق الطبقية والتفرقة ما زالت قائمة، ولو كانت بصيغة أخرى. لقد تخلصت الثورة السبتمبرية من حكم آل حميد الدين، لكنها لم تتخلص من أطروحة الإمامة إلى اليوم. لقد ساهمت الإمامة الزيدية في تقسيم المجتمع إلى طبقات متعددة. اختلف المفكرون والباحثون في شكل هذا التقسيم، لكن وفقًا لكتاب «اليمن تحت حكم الإمام أحمد» لأحمد حميد بن دغر، فإن التقسيم الاجتماعي كان إلى ثلاث طبقات رئيسة: طبقة عليا (أرستقراطية)، وتجارية إقطاعية وسطى، كادحة وفلاحية وعمالية دنيا. في الطبقة العليا، كان السادة والقضاة، وفي الوسطى كان مشائخ القبائل، كبار ملاك الأراضي، والتجار، وكبار موظفي الدولة، أما في الطبقة الدنيا، فهم باقي المجتمع.
الآن ما حدث بعد الثورة هو إعادة إفراز طبقية جديدة يكون في هرمها مشائخ القبائل بدلًا من إلغاء الطبقية وبناء مجتمع على أساس المواطنة المتساوية. وقد تجلّت بوضوح هذه الهرمية الجديدة في عهد الإرياني عن طريق استحواذ مشائخ القبائل على أغلب مقاعد مجلس الشورى. ولهذا، الحمدي، وبالرغم من أن مشائخ القبائل هم من مكّنوه من اعتلاء السلطة في بادئ الأمر بحكم سطوتهم، لم يكن — كما يزعم السعيدي — على خطأ فيما قام به من إصلاحات، بل على العكس تمامًا، كان يتجه بكل ثقله نحو حل التوتر الذي ذكرناه مُسبقًا. وذلك عن طريق تقويض سلطة المشائخ وتفكيك القبيلة كمؤسسة بائدة. والحمدي، لم «يفكك التعاونيات» كما يدعي السعيدي، بل على العكس عززها أكثر عن طريق جعلها جزءًا من الهيكل التنموي للدولة، فعن أي تفكيك يتحدث السعيدي وهي تحولت في عهد الحمدي من مجرد مبادرات محلية متفرقة ومحدودة للغاية، إلى جزء من هيكل واحد منظم ومركزي تقدم له الدولة الدعم الفني والموارد الأساسية وبعض التمويل المالي. إن ما قام به الحمدي هو في حقيقة الأمر ما جعل عملية التنمية متسارعة الوتيرة، لأن العمل الهيكلي المنظم أسرع من المبادرات المتفرقة. وهذا أمر لا يختلف عليه أحد. ويجب التنويه أنه في عهد الإرياني، لا تعدو التعاونيات كونها مبادرات فردية بسيطة ومحدودة من ناحية الاتساع والانتشار يقوم بها مغتربون طامحون لتطوير مناطقهم، ولم تقودها القبيلة بشكلها المؤسسي كما يزعم السعيدي، ولا علاقة للقبيلة كمؤسسة بها. فضلاً عن أن فكرة التعاونيات هي فكرة يسارية عالمية، وقد ابتدأت في عهد الإرياني في مناطق يسارية الميول غير قبلية، وهي الحجرية (تعز). وفي عهد الحمدي، توسعت رقعة هذه المبادرات نُظّمت هيكليًا بشكل ديمقراطي فعال ومنظم، وشكَلَ الدعم المادي (ولو كان بسيطًا، إذ شكل فقط 25% من عائدات الزكاة) حافزًا قويًا لانتشار التعاونيات كالنار في الهشيم. لهذا، حينما يتحدث السعيدي عن أن التعاونيات كانت فعالة في عهد الإرياني، وأن جُل ما قام به الحمدي كان فقط حصد ثمار تعاونيات سابقة لعهده؛ فأنا لا أعرف عما يتحدث. لكن لعل التفكيك الذي يتحدث عنه السعيدي حدث على مستوى القبيلة من حيبث هي مؤسسة، وليس التعاونيات، فقد أتت كبديل للمؤسسة القبلية، فلا يعود التنظيم كأفراد قبيلة وشيخ مُسلط عليهم، بل كأفراد عُزلة أحرار ينتخبون ممثلهم ديمقراطيًا (وربما أكثر من ممثل) لتمثيلهم في الهيئة التعاونية على مستوى المديرية.
الأمر أشبه بتحويل القبيلة كمؤسسة إلى مُنجَمع أهلي تعاوني ذو أساس ديمقراطي يندرج ضمن منجمع تعاوني أوسع، وهلمّ جرّا. وهنا تكمن عبقرية الحمدي وإبداعه، هنا يكمن تخصيص الفكرة (التي يصفها السعيدي بالمستوردة) بشكل يستهدف تغيير البنية الاجتماعية بطريقة مبدعة: جمهورية ذات طابع مُنجمعاتي أهلي تعاوني ديمقراطي. صيغة فعالة للجمهورية تتناسب مع واقع اليمن، وتسمح تدريجيًا بالقضاء الفعلي على القبيلة مع ضمان التنمية في ذات الوقت، وإليكم هيكلها التنظيمي الذي يتجه من الأسفل إلى الأعلى، أي بشكل تصاعدي لا تنازلي:
يبدأ الأمر بلجنة تعاونية على مستوى العُزلة (قرية كبيرة)، يكون لها ممثل أو ممثلون منتخبون بشكل ديمقراطي (حسب عدد سكانها، بحيث ممثل واحد لكل 500 نسمة) في هيئة التعاون الأهلي، وهي هيئة على مستوى المديرية (المديرية تضم عدة عزَل)، وتمثل المديرية النطاق الفعلي لهيئة التعاون. وتتكون من الجمعية العمومية والهيئة الإدارية، ويكون ممثلو العُزَل ضمن الجمعية العمومية، وتَنتخب هذه الجمعية الهيئة الإدارية، وهم إما سبعة أو تسعة أو إحدى عشر شخصًا. وتتكون الهيئة الإدارية من رئيس وأمين عام ولجان تخصصية (كالمالية مثالًا). ثم يأتي مجلس تنسيق بين التعاونيات على مستوى المحافظة، ويتكون من ممثلين إما تختارهم الهيئات الإدارية لكل تعاونية، أو يتم انتخابهم مباشرة من قبل الجمعية العمومية مع تزامن انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية عن طريق اقتراع سري.2
ثم يأتي الاتحاد العام لهيئة التعاون الأهلي للتطوير على مستوى البلاد بأكملها، ويتكون بطريقتين: إما عن طريق اختيار مجالس التنسيق ممثلًا لها، أو يُنتخب ممثل من الجمعية العمومية في التزامن مع انتخاب ممثل لها في مجلس التنسيق. وأخيرًا، المؤتمر العام لهيئات التعاون الوطني للتطوير، يتشكل من ممثلي كل المديريات في مجلس التنسيق، ويُعقد كل خمس سنوات. ويقوم بانتخاب الهيئة الإدارية للاتحاد العام لهيئة التعاون الأهلي للتطوير. ويُشترط لمن يشغل منصبًا في الهيئة الإدارية للاتحاد العام ألا يشغل أي وظيفة حكومية من الدرجة الأولى (لا وزير، ولا نائب، ولا وكيل، ولا رئيس مؤسسة).
وللتذكير فقط، لمن فقد تسلسل بحثنا، فقد يبدو أننا نثبت كلام السعيدي بذكرنا لمسألة تفكيك القبيلة، غير أنّ القارئ إذا عاد إلى ما أوردناه آنفًا، حول أن الفكرة لا يجب أن تنسجم مع الواقع، بل أن هذا ليس عملها أصلًا، لاتضحت له الأمور. مع ذلك، لا ضير في ترتيب الأمر: قلنا أن الشعب ثار على أطروحة الإمامة (الاستبداد، الظلم، الفوارق الطبقية) مستخدمًا نقيضها (التحرر، العدل، المساواة). بعد قيام الجمهورية، ظلت أطروحة الإمامة قائمة، حتى اليوم، لكن بصيغة مختلفة. القبيلة هي شكل آخر من أشكال الاستبداد اليوم، في هذا العصر الذي لا يقبل الجمعانية، لا يقبل توكيد الجماعة على حساب استقلالية الفرد، ولا يقبل تسلط فرد على جماعة، ولا يرضى بالامتيازات التسلطية المتوراثة الممنوحة للشيخ بشكل خاص وللذكر بشكل عام.
القبيلة كيان مُتَقادم سابق للدولة، كان ضروريًا في مرحلة أولية في تاريخ البشرية، لهذا كان يمكن أن يتغاضى المرء عن عيوب هذا الكيان. لكن اليوم، في عصر الانفتاح على العالم، في عصر أفكار الحرية والاستقلال والعدل والمساواة، بعد ظهور مفهوم الدولة والمواطنة المتساوية وكل المفاهيم الحداثية الأخرى، لا تعدو القبيلة كونها عائقًا، ليس للدولة فحسب، بل للفرد أيضًا. وما الدولة إلا وسيلة جديدة للتنظيم، تحمل في طياتها إمكانية كبيرة وقدرة على استيعاب أفراد كثيرين من غير التنازل المبالغ فيه عن حرية الفرد بالضرورة، وذلك على عكس القبيلة التي تكتفي بتنظيم عدد قليل من الناس مقابل خضوعهم لسلاسل الجمعانية وللامتيازات التسلطية للشيخ والذكر.
الذي يدافع عن القبيلة، كمن يدافع عن بقاءه في الأغلال، يعيش نوعًا من رُهاب الحرية، أو أنه لديه امتيازات ما يجدها في هذا الشكل الجمعاني البدائي. عادةَ أصحاب الامتيازات (وهم قلة شديدة) المستفيدون من الأمر، قد يروجون لأفكار تثير في نفوس بقية الأفراد الخوف والهلع من التحرر. على سبيل المثال، قد يروجون أن القبيلة هي وسيلة للحفاظ على الهوية، على التقاليد، بل حتى على العائلة، في حين أنهم يدافعون عن امتيازاتهم الشخصية، ويبثون في نفوس الأفراد أنهم سيخسرون كل شيء إذا تفككت القبيلة، في حين أنهم في الواقع لا يملكون أي شيء ليخسرونه، بل كل شيء ليكسبونه، فقد سلبهم أصحاب الامتيازات كل شيء، حتى استقلالهم كأفراد.
لهذا، فإن تفكيك القبيلة هو حل هذا التوتر بين الأطروحة والنقيضة، وأي مسار يخدم هذا التفكيك هو المسار الوطني الصحيح. ولهذا كان صعود الحمدي للسلطة خطوة تصحيحية هامة لمسار الثورة، الذي كان قد بدأ يميل أكثر نحو أطروحة الإمامة. إن ما لا يفهمه السعيدي، أو يحاول أن يجعل منه أمرًا سيئًا، هو مسألة الصراع نفسها. على أنّ الهرب من الصراع يعني التقهقر، ويفضي لتغليب أطروحة الإمامة على نقيضها. ينبغي أن ينظر للصراع دائمًا بشكل إيجابي، كعلامة ومؤشر للتقدم.
ماذا عن جنوب اليمن؟ في واقع الحال، ما يمكن قوله على الشمال هو ذاته الذي يمكن قوله على الجنوب. الجنوب ينبغي أن يتحرر أيضًا، لأنه لديه ذات المشكلة، ولو بشكل خاص. السعيدي يتحدث عن أن ما فعله الرفاق اليساريون في ثورة أكتوبر هو «انقلاب على الترتيبات»، وأنه لم يكن لهذه الثورة ضرورة، فقد كان الاحتلال البريطاني سيخرج، وكانوا قد اتفقوا على نظام سلطناتي اتحادي، وأن الثورة أفسدت ذلك. وحتى لو انجرينا وراء هذا القول، فما زالت حجتنا السابقة قائمة، ولهذا قلت إن ما يمكن قوله على الشمال، وهو في جوهره، ذاته الذي يمكن قوله على الجنوب.
رحيل الاستعمار وترك سلطانات بعده يحافظ على نفس أطروحة الاستبداد، لكن بصورة أخرى. يبقى الاستبداد استبدادًا، سواء استبدّك أخوك أو الغريب. لهذا، كانت ثورة أكتوبر ثورة ضد الاستبداد كفكرة. (لا شأن لي إذا بقي شكل آخر من الاستبداد بعدها، فهذا أمر طبيعي، المهم في البداية تأسيس فكرة رفض الاستبداد. فإذا لم تقم الفكرة، فلا يحق لنا أن نتذمر. إن ما قد يسمح لنا بنقد أي ممارسات استبدادية لليسار في الجنوب هو الفكرة ذاتها).
وبالرغم من هذا الأمر يجمع عليه كثيرون، فلا ضير في ذكره: الحزب الاشتراكي ليس الملام على حرب 1986 بصورة مباشرة، أي ليست أفكاره اليسارية بالضرورة هي من قادت للحرب، لم يكن الاختلاف أيديولوجيًا بالضرورة، ولو تجلى كذلك. كانت المهمة التي على عاتق الحزب كبيرة للغاية، وتكمن في التخلص من شكل آخر من الجمعانية، تجلّى على مستوى أكبر من القبيلة، وهي الجمعانية السلطنية. العقلية السلطنية تسربت إلى الحزب، وحاولت قيادة الحزب بهذا الأسلوب، أي أن يكون ظاهره تحرري جمهوري يؤمن بالعدالة الاجتماعية، وداخله سلطني جمعاني.
لهذا قال علي ناصر في مقابلة تلفزيونية حين سُئل عن مقتل عبدالفتاح إسماعيل إنه «ضاع وسط الزحمة»، وهو اعتراف منه أن عبدالفتاح إسماعيل (كونه شمالي، تربية الحجرية) ضاع في خضم صراع سلطني قبلي. وهي عبارة ساخرة من علي ناصر، تعني أن عبدالفتاح لم يستوعب أبعاد وخطورة العقلية السلطنية التي بدت دخيلة عليه، فضاع وسطها. إن هذا ما يجب على جنوب اليمن التحرر منه. وهذه هي العقلية ذاتها التي قادته لخسارة «الجنوب».
كان على البيض الصمود والمقاومة في صنعاء، لقد كان هناك الكثير من الاحتقان الشعبي ضد علي عبدالله صالح وممارساته، لكنه فضل التقهقر وفك الارتباط، والسبب في ذلك أنه لم يتعامل مع اليمن ككل باعتبارها وطن. لقد منعه ذلك عقليته السلطنية (هذه بلادي وتلك بلدك، هذه منطقتي وتلك منطقتك). يُعزي السعيدي خسارة الحزب الاشتراكي في حرب عام 1994 إلى أنّ الحزب كان قد قضى مسبقًا على القبيلة، فلم يعد هناك من يدافع عن الجنوب ضد قبائل الشمال. وهذا حُمق كبير وإهمال لحقائق كثيرة في التاريخ، منها أن الحزب الاشتراكي كان الحزب الأقوى في اليمن على الإطلاق قبل الوحدة، لأن الحزب يمتد جنوبًا وشمالًا، وله أنصار ومنتسبون كثيرون في الشمال، ولم يؤسس قط كحزب جنوبي يمني، بل كحزب يمني موحّد، وقد انطوت تحته العديد من الأحزاب الشمالية التقدمية. ولهذا كان عنده من القوى ما لا يمكن تخيله، ولعل حرب 1979 شهادة على قوة هذا الحزب، الذي وصل حتى أبواب صنعاء. ولولا الضغوط الدولي، وتهديد الاتحاد السوفيتي بقطع السلاح عن الحزب في حالة عدم انسحابه، لكانت اليمن اليوم موحدة تحت راية الحزب الاشتراكي. لقد خسر الحزب حرب 1994 بسبب البيض، قرار فك الارتباط لم يكن يلائم طموحات الشعب وكان مربكًا وغير مفهوم للكثيرين، فلهذا لم يقاتلوا بجدية كافية للنصر. إن شعبية الحزب الاشتراكي بعد الوحدة كانت في تزايد وليس في تناقص، خاصة في الشمال، ولم يكن من المنطقي الانسحاب والتقهقر للوراء وتخيب آمال الشعب شمالًا وجنوبًا. كان على البيض أن يقف ويواجه، والشعب سيكون معه، لكنه فضل أن يعود لسلطنته ليتفرد بالحكم بشكل مريح.
اليوم هناك من يحاول تكرار الأطروحات القديمة، ولو بنكهة جديدة، سواء في الجنوب أو الشمال. لهذا يزعل البعض حينما يصفهم اليسار بأنهم رجعيون، ويعتقدون أن هذه سبة، في حين أنها مجرد وصف واقع. الأمية في جنوب اليمن في عهد السلطنات كانت تصل إلى 90%، تخيلوا أن أغلب الشعب لا يجيد أحد أهم الأساسيات في الحياة، وهي الكتابة والقراءة، وقد استطاع الحزب الاشتراكي أن يخفض هذه النسبة بشكل كبير إلى حوالي 16.4% بحلول عام 1972 وبعدها أتت حملة 1984 واستهدفت 194,000 مواطن، مما يعني أن الأمية بعد الحملة من المرجح أنها انخفضت إلى 7.5%.34 في حين فشل الشمال في عكسها تلك الفترة، فحتى الثمانينات كانت نسبة الأمية تصل إلى 80%، مقارنة بـ95% أيام الإمام، وظلت في حدود 90% في النساء. ذلك أن الحرب الداخلية على الجمهورية من قبل القبيلة كانت شديدة للغاية، ولم يكن النظام بالصرامة الكافية للتعامل مع القبيلة، فكانت أغلب الأنظمة المتعاقبة تحاول أن تتصالح مع القبيلة، باستثناء نظام الحمدي. لهذا يعتبر الحمدي استثنائيًا ومهمًا في تاريخ اليمن الشمالي. وأي معاداة للحمدي هي معاداة للجمهورية، لأن الحمدي فكرة قبل أن يكون شخصًا. يعلمنا الحمدي أن الطريق لبناء الدولة هو بتفكيك القبيلة والتخلي عنها، وإبعادها كل البعد عن السلطة، وأن الحكم للشعب لا للشيخ.
لهذا، حينما يتحدث السعيدي عن «نظام يشبهنا» فأنا بحق لا أفهم ماذا يعني. أيريد أن يقول إن الاستبداد والظلم والقهر الطبقي والمناطقي والجمعاني هم نحن، وأن النظام يجب أن يستوعب هذه العناصر؟ أم يريد أن يقول إن هذه هويتنا، هكذا عشنا وهكذا يجب أن نظل نعيش، لهذا يجب أن نبحث عن نظام يكرس ذلك لا ينفيه؟ ما يجب البحث عنه ليس نظامًا «يشبهنا»، بل نظامًا يسمح لنا بشكل تدريجي لكن متسارع، لكي نكون أفضل مما نحن عليه، نظام يغير من البنية الاجتماعية الحالية. لا نريد النظام أن يكون مرآة لأنفسنا، بل وسيلة ليرتقي بنا.
وهذا النظام هو الجمهورية، لأنه مبدأ أساسي نستطيع أن نبني عليه كل مفاهيمنا الأخرى. إن ما يحاول السعيدي نفيه ليس كلمة «الجمهورية»، بل حق كل مواطن في اختيار حاكمه، أي أن يكون الشعب هو الحاكم الفعلي. لهذا فإن أطروحة السعيدي تتضمن في ثناياها أطروحة الإمامة، أطروحة الاستبداد. أتفهم أن وراء حجة الاستيراد إرادة تريد أن تبدع، لا تقلد. ولطالما كنت وسأظل مع فكرة عدم تقليد النماذج، لكن الإبداع لا يكون بالرجوع للخلف، بل بالمضي قدمًا أبعد مما قد وصل إليه امرؤٌ قط. وهذا ما لم يدركه السعيدي.
ثم إن الجمهورية، كما ذكرت، مبدأ أساس، يُبنى عليه. فالجمهورية لا تقول لنا كيف سنفكك القبيلة، لكنها تمكننا من ذلك، تخلق لنا الإطار النظري، وإبداعنا سيكون هنا، في البحث عن أساليب فعالة وسريعة لتفكيك القبيلة، لتحرير الإنسان. إن النظام الجمهوري في اليمن لن يكون كأي نظام في العالم، بل سيكون أبدع وأضخم. سيكون إبداعنا في أن نجعل من نظامنا الجمهوري مثالًا يُحتذى به، مثالًا يعزز من خوف الممالك المحيطة، التي لطالما حاولت إحباط جمهوريتنا (وهي تحاول اليوم، بعد أن مزقت البلاد، أن تمزق الفكرة ذاتها)، لكنه سيخلق أملًا لتحرر الفرد على امتداد العالم العربي، بل حتى في العالم بأسره، بكل ممالكه وجمهورياته.
نهاية القول: جمهورية ومن قرح يقرح!
الهامش
- الريحاني، أ. (1924). ملوك العرب. مؤسسة هنداوي. الفصل: الإمام يحيى بن حميد الدين المتوكل على الله. ↩︎
- العودي، حمود. (2023، 10 أكتوبر). تجربة التعاونيات في اليمن [مقابلة تلفزيونية]. في أ. الزرقة (مقدم)، سلسلة الشاهد 3 (الحلقة السابعة). منصة يوتيوب. https://www.youtube.com/watch?v=6PN3V9LCyZk ↩︎
- تم احتساب النسب استنادًا إلى البيانات الواردة في تقرير دراسة الحالة الصادر عن اليونيسف ↩︎
- Fata, M. S. (1988). The 1984 Literacy Campaign in the People’s Democratic Republic of Yemen: A Case Study. ED.88/WS/43. Paris: UNESCO, Unit for Co-operation with UNICEF and WFP. ↩︎