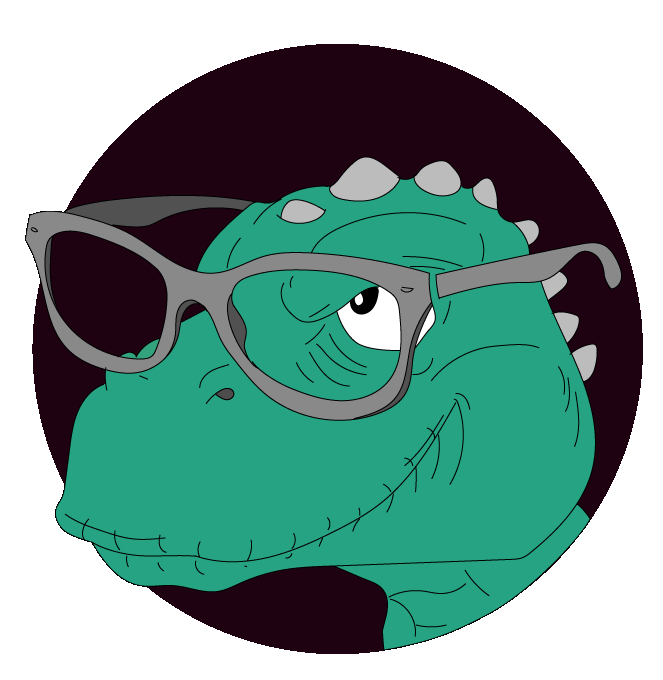القرن الواحد والعشرون، هو زمن انتشار وهم الثراء في العالم العربي كالنار في الهشيم، مدفوعًا بتطورات تكنولوجية هائلة مثل ظهور الإنترنت والقنوات الفضائية والهاتف الذكي. هذه الأدوات الحديثة أسهمت في نشر الثقافة الرأسمالية الأمريكية، حيث تُعَدُّ أمريكا اليوم معقل الرأسمالية العالمي. وفي هذا العصر، باتت التجارب الاشتراكية مدانة ومرفوضة في نظر جيل التسعينيات والألفية الجديدة، وأصبح حلم الثراء هو الهدف الأسمى.
وصار الشباب يعتقدون أن تحقيق الثروة بات قاب قوسين أو أدنى، وفي العقد الأخير، ارتفعت أعداد المروجين لوهم الثراء على وسائل التواصل الاجتماعي بالتوازي مع تزايد انتشار الرأسمالية في البلدان العربية. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، رُسخت فكرة أن الرأسمالية هي النظام الباقي، الحل الأمثل لكل مشكلات الإنسان. وأصبحت الاشتراكية تُعتبر فكرة طوباوية غير واقعية، بل وصار ينظر إليها كظلمٍ مجسَّد، تحرم الأفراد من حق التملك وبالتالي حق الثراء الفاحش. ولعل فشل التجارب الاشتراكية ساهم في تعزيز هذه النظرة.
وقد انتشر حلم الثراء بين الشباب، فأصبحوا يرون في عصر الرأسمالية بوابة لتحقيق أحلامهم. وكما مثلت قصص النجاح لبعض الشخصيات الغربية الشهيرة شعلة الأمل للشباب العربي (بل للشباب العالم أجمع)، تُوهمهم بأن الثراء الفاحش ممكن. ولكن، هل هو ممكن حقًا؟ وهل يمكن للجميع أن يحققوا الثراء في ظل النظام الرأسمالي العالمي؟ لكي نفهم ذلك علينا أولًا البحث في آليه عمل هذا النظام الرأسمالي وفي طبعيته ونشأته.
إنّ النظام الرأسمالي هو بنية اقتصادية تتميز بتقسيم طبقي واضح، حيث تقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والسوق الحرة والمنافسة كآليات أساسية. وفي هذا النظام، يكون دور الدولة محدودًا، ويعتبر الربح هو الدافع الأسمى الذي يحرك عجلة الاقتصاد. ولكن، ما هي الإشكالية في هذا النظام؟ وأين تكمن عيوبه؟
في الواقع، يفضي النظام الرأسمالي إلى تركيز الثروة في أيدي فئة قليلة، مما يؤدي إلى تقسيم المجتمع إلى طبقات اجتماعية واضحة المعالم. فالأغنياء يحتكرون وسائل الإنتاج، ويستغلون الفقراء من خلال ما ينتجه العامل من قيمة أعلى من قيمة تكاليف توظيفه (فائض القيمة) التي ينتجونها، مما يزيد من ثروات الأغنياء.
لنضرب مثالًا لتوضيح المشكلة: تخيل أن العالم يحتوي على مليون دولار فقط. إذا استحوذت الأقلية، التي قد تتكون من فرد أو اثنين، على معظم هذه الأموال، فإن الأغلبية لن تنال إلا الفتات. وهكذا، فإن حلم الثراء يصبح وهمًا لا يمكن تحقيقه إلا على حساب الغالبية. لا يمكن للجميع أن يصبحوا أثرياء بنفس الدرجة؛ فلا يمكن أن يكون الجميع مثل جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون. كمية المال محدودة، والنظام يعتمد على التراكم. هذا التراكم في أيدي القلة يزيد من تعقيد المشكلات الاقتصادية؛ فمهما تمت طباعة المزيد من النقود، فإنها ستؤدي فقط إلى تضخيم التراكم لدى القلة، وزيادة التضخم الاقتصادي، الذي يضر بالشعوب، باعتبارها المستهلك الرئيس.
أما إذا كان طموحك هو أن تصبح صانع محتوى مشهور على وسائل التواصل الاجتماعي (أو الوسائط الاجتماعية)، مقلدًا شخصيات مثل «بيوديباي»، فاعلم أنك لم تستوعب بعد أبعاد اللعبة الرأسمالية. حتى «بيوديباي» يتقاضى جزءًا بسيطًا مقارنةً بمنصة «يوتيوب» التي ينشر عليها، حيث تُقدّر ثروته بنحو 40 مليون دولار، بينما إيرادات «يوتيوب» تصل إلى حوالي 35 مليار دولار سنويًا. فإذا سمح لك الرأسمالي بجني مبلغ معين من المال، فإن ذلك لا يعني سوى أنه يحقق منك أضعاف ما أعطاك إياه. وغالبية ثروة «بيوديباي» تأتي من مصادر متنوعة أخرى، مثل الإعلانات المباشرة التي يقدمها لشركات متعددة. لكن إذا كنت راضيًا بـ40 مليون دولار، فإنك لم تستوعب بعد طبيعة اللعبة. ما هي فرصتك الحقيقية لتحقيق حتى ربع ثروة «بيوديباي» في ظل تعقيدات الخوارزميات ومعايير التربح والمنافسة الشديدة الناتجة عن الهوس الجماعي بالثروة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ على «يوتيوب»، أنت تتنافس مع أكثر من 50 مليون حساب نشط، مما يجعل فرصك لا تتجاوز 0.01%. ألم تدرك بعد أن الطبقة العليا تجرّك في سباق منهك ومستحيل، تمامًا كالحمار الذي يلاحق جزرة معلقة بخيط، والخيط متصل بعصا في يد راكب الحمار حيث يستفيد راكب الحمار، لكن الحمار لا يحصل على جزرته أبدً؟! تسلب هذه الشركات بياناتك، لتجني من ورائها ثروات طائلة، بل وتحصد حتى مشاهدات فيديوهاتك، بينما تعطيك أنت الفُتات. وإذا لم تكن مؤهلًا بعد لبرامجها الربحية، فإنك لن تحصل حتى على الفُتات.
وليس الكادحون أو الطبقة العاملة1 وحدهم من يعانون من تبعات النظام الرأسمالي، بل حتى البرجوازية الصغيرة، مثل أصحاب المتاجر الصغيرة والحرفيين. فالشركات الرأسمالية الكبرى تسحق هذه الفئة الصغيرة، مما يضعها على شفا الانقراض. وحتى إن بقيت بعض هذه الأعمال، فإنها تواجه منافسة شرسة من القوى الرأسمالية الكبرى. وبهذه الطريقة، تصبح المنافسة غير عادلة، ويظل البقاء للأقوى، أو بمعنى أدق، للقلة الثرية.
إن الثراء ليس سوى سراب مضلل، نسجت خيوطه الرأسمالية كحيلة للبقاء، وألقته كستار يغطي تناقضاتها المتفاقمة. هو غشاوة على أعين البشر، يحجب عنهم رؤية الحقيقة، ويدفعهم إلى ملاحقة أحلام خادعة، حتى ينقضي العمر دون أن يحصدوا منه شيئًا. وعندما تتكشف الحقيقة، يكون الأوان قد فات، إذ لم يعد هناك شيء يمكن فعله. وهكذا يستمر الجيل القادم في مطاردة السراب ذاته. إن عدم فهم إشكالية الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج يحجب عنك إدراك حقيقة وهم الثراء. إذ بإقرارك بأن الملكية الخاصة حق، فإنك تعزز هذا النظام الرأسمالي وتعيش في تناقض مع نفسك، فأنت تسعى للثراء ولكنك بنفس الوقت تعيق نفسك عن بلوغه. فلا ثراء في النظام الرأسمالي إلا للقلة الذين سبقوك بالفعل بتملك وسائل الإنتاج.
وحتى إذا ما تم إيضاح هذه المشكلة لك، فإن إقناعك لن يكون سهلًا لأن مفهوم الملكية الخاصة متجذر في وعيك، مما يجعلك تراه حقًا مشروعًا. ولكن من أين أتت هذه القناعة؟ كيف استنتجت أنه حق؟ على أي أساس استندت في هذا الحكم؟ وما هي المبررات المنطقية التي تدعم هذا الرأي؟ أهو حق طبيعي أم قانوني أم كلاهما معًا؟ فإذا كنت تعتقد بأنه حق طبيعي، كما هو الحال عند جون لوك، فإن حجته هشة، بل يمكن تفنيدها بسهولة حتى من قبل طفل في العاشرة. إذ يقر جون لوك بمشاعية الأرض2 والموارد في بداية تاريخ البشر، لكنه يرى أن الإنسان له حق طبيعي في التملك، ويكتسب هذا الحق عن طريق خلط عمل يده مع الأرض. فإذا زرع المرء أرضًا، صارت له، لأنه كما يقول، خلط عمل يده مع الأرض وبالتالي أضاف شيئًا جديدًا على الأرض المشاعة. ومع ذلك، إذا أخذنا بهذا المعيار، فهذا يعني أن الفلاح، الذي يعمل في أرض إقطاعي ما، يمكنه أن يمتلك هذه الأرض وينتزعها من الإقطاعي، لأنه هو الآن من يخلط عمل يده مع الأرض، لا الإقطاعي.
وفيما يتعلق بأنواع التملك الأخرى التي لا ترتبط بوسائل الإنتاج، فلا تهمنا في هذا المقال. فتركيزنا الأساسي هنا هو الملكية الخاصة بمفهومها الماركسي، والتي ليست مجرد امتلاك لشيء ما (أي علاقة بين مالك وشيء)، بل هي علاقة اجتماعية بين مالك وعامل، حيث يستحوذ المالك على كل ما ينتجه العامل في إطار ما يصفه المالك بأنه ملك له. أما إذا كنت تعتقد أن الملكية حق قانوني، فهذا أضعف قول. فالقانوني إذا لم يستند إلى الطبيعي يبقى مجرد عُرف لا أكثر، ولا يحمل صفة عالمية. فضلًا عن ذلك، ما هو هذا الحق الذي يتوفر فقط لقلة من الناس بينما يُحرم منه أغلب الشعوب؟! كيف يمكن اعتباره «حقًا» إذا لم يكن متاحًا للجميع؟! المشكلة في الملكية الخاصة هي أنها موجودة، ولكنها موجودة حصرًا للقلة، مما يعني أنها فعليًا مُلغاة بالضرورة بالنسبة لغالبية الشعوب. وفي هذا السياق، يقول كارل ماركس وانجلز:
لقد أصِبتم بالذعر لأنّـنا نريد إلغاء الملكية الخاصة. و لكن الملكية الخاصة، في مجتمعكم الراهن، ملغاة بالنسبة إلى
تسعة أعشار أعضائه. إنّها ضبطا موجودة لأنها غير موجودة بالنسبة إلى الأعشار التسعة. فأنتم إذن تلوموننا لأننا نريد إلغاء ملكية تَفرض، كشرط ضروري لوجودها، إنعدام الملكية بالنسبة إلى الأغلبية الساحقة من المجتمع.كارل ماركس وفريدريك انجلز، البيان الشيوعي
ومن الجدير بالذكر أن لا أحد عاقل اليوم يستطيع أن ينكر أن الملكية الخاصة هي المتسبب الرئيس في التقسيمات الطبقية سواء كان ماركسيًا أو مناهضًا لها. فالخلاف كان حول ما إذا كانت «حقًا» أم لا، ثم تحول الخلاف إلى ما إذا كانت جزءًا من طبيعة البشر، وشيئًا ينبغي أن نسلم له ونخضع، وأنه لا مجال لتغييره، أي أنه أمر واقع.
لكن دعونا نتجاوز هذه التفاصيل المعقدة، فالمسألة تتعلق بجوهر أساسي. فما يهمنا هو أن التملك لم يكن ظاهرة موجودة على الدوام منذ بدء البشرية، وإنه قد ظهر في مرحلة مبكرة من التاريخ البشري، وتحول فيما بعد إلى حق معترف به. وهذا التحول أفضى إلى امتلاك وسائل الإنتاج، مما أدى إلى نشوء الملكية الخاصة كحق قانوني. ومن هنا، أفرزت الملكية الخاصة تقسيمات طبقية واضحة واستغلالًا بين البشر. الأهم هنا، هو أنه طالما بقيت الملكية الخاصة، سيظل هذا الاستغلال وهذه الطبقات غير العادلة قائمة. وبالتالي، دون معالجة جادة لهذه المسألة، لن يكون هناك مجال لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وبالنظر إلى فشل الأنظمة الاشتراكية أو الشيوعية السابقة، مثل الاتحاد السوفيتي، قد يتساءل البعض: «أليس هذا دليلاً على فشل الماركسية وأن الرأسمالية هي النظام الأمثل الذي علينا قبوله، مع محاولة تحسينه وتخفيف آثاره السلبية؟». الرد هنا يكمن في أن الترقيعات والتحسينات تحدث بالفعل، لكن معدل تراكم التناقضات والمشكلات داخل النظام الرأسمالي يتجاوز قدرة تلك الترقيعات على حلها. وهذه الترقيعات ليست سوى حلول مؤقتة، تهدف إلى إطالة عمر النظام ذاته، كما يحاول الجسم البشري الدفاع عن نفسه ضد الأمراض الفتاكة. ومع ذلك، لا يستطيع هذا الجسم إيقاف الشيخوخة، التي هي مرض أيضًا، وإنما فقط إبطاءها عبر إجراءات صحية. وهكذا الحال مع النظام الرأسمالي؛ فهو يشيخ يومًا بعد يوم، وكل ترقيع لا يعدو كونه حلاً مؤقتًا.
إن من يعتقد بفشل الأنظمة الشيوعية، والتجاوز، الظاهري، للأزمات الاقتصادية العالمية هما دليلان على أن النظام الرأسمالي يعالج نفسه بنفسه، أو أن الرأسمالية هي النظام الأفضل والوحيد وأنها «نهاية التاريخ»، يتجاهل حقيقة أن العالم في حالة صيرورة دائمة. فتمامًا كما ظهرت الرأسمالية من رحم النظام الإقطاعي، سيأتي يوم ينبثق فيه نظام جديد من الرأسمالية. قد نختلف حول التسميات، سواء «شيوعية» أو «اشتراكية»، ولك الحق أن تكره كلمة «شيوعية» أو «اشتراكية» أو أي تسمية أخرى. لكنك لا يمكنك ابدا الوقوف أمام هذه الصيرورة الدائمة. مشاعرك وعواطفك وحقدك التافه (أقول تافه ليس للشتم بل للتقليل من شأنه) ليس لها أدنى تأثير على مجرى التاريخ. فالمادية التاريخية، تثبت أن التطور التاريخي والاجتماعي يتحدد بشكل رئيس من خلال القوى الاقتصادية وعلاقات الإنتاج. وفي سياق آخر، يمكن توضيح هذا المفهوم من خلال فلسفة العلم، وبالتحديد مفهوم «النموذج المعرفي»3 أو المنوال الذي قدمه توماس كون عام 1962. يوضح كون أن العلم لا يتقدم بشكل خطي ومستمر، بل عبر ثورات علمية، حيث تتراكم الشذوذ أو الاكتشافات التي لا تتوافق مع النموذج السائد، مما يؤدي إلى استبدال هذا النموذج بنموذج جديد. وبالمثل، تتراكم التناقضات في نمط الإنتاج الحالي (الرأسمالي) حتى تصل إلى نقطة تستدعي تحولًا ثوريًا إلى نمط إنتاج جديد، تماما كما يحدث في الثورات العلمية.
وأخيرًا يجب أن نفهم أن التجارب الاشتراكية السابقة ليست نهاية الاشتراكية، بل كانت مجرد محاولات أولية. هذه التجارب ليست نقاطًا سوداء في التاريخ، بل تُشكل ثروة معرفية مهمة تتيح لنا تحديد نقاط الضعف وتطوير النظرية بشكل أفضل. ولا يكفي وصول التناقضات في النظام الرأسمالي إلى أقصى حدوده ليؤدي ذلك لانهيار النظام؛ إذ ينبغي أيضًا توافر بديل نظري جاهز، كما يحدث في تقدم العلم حيث يجب أن يتوافر نموذج فكري جديد ليحل محل القديم.
ومع ذلك، فإن التناقضات داخل النظام الرأسمالي نفسه هي التي تدفع باتجاه إيجاد هذا البديل. ووهم الثراء الذي ينتشر في أوساط الشباب، وهو محور مقالنا، يعكس إحدى هذه التناقضات. هذا الوهم لا يتوافق مع آليات عمل النظام الرأسمالي، بل يكشف عن الفجوة بين الواقع والطموحات. ومن المثير للسخرية، أن الترويج لوهم الثراء هو آلية بقاء هذا النظام، وهو أيضا ما سينقضه. فالآمال التي يرفعها هذه النظام لا تتوافق مع قدراته. وما طار طيرٌ ورتفع إلا كما طار وقع.
احرص على أن يصلك جديد عن طريق الاشتراك في النشرة البريدية